توب أضلاع المُعلِمات
الزيّ والانضباط والتقدّم
في أوائل مايو 1944، احتشدت أكثر من ثلاثمئة أمٍّ وجدّةٍ وعمةٍ وابنةٍ وأختٍ في ساحة مدرسة البنات بالنهود لمتابعة عرضٍ قدّمته 142 تلميذةً مما تعلّمتهنّ خلال العام الدراسي. دُعي عدد قليل من الرجال، هم بعض الموظفين الإقليميين والقاضي المحلي ومديرو مدرستَي الأولاد في المنطقة، والمفوّض الإقليمي ت. ر. هـ. أوين. وقد استُقبل الحضور في احتفال “يوم الأم” بالشاي والكعك، وتبادلوا أطراف الحديث مع المعلمات بينما كان فرقة شرطة أم درمان تعزف من وراء شاشة، ممسكين بزجاجاتِ “المريسة” لتبقى معنوياتهم مرتفعة.
قدّمت الطالبات فقراتٍ غنائية وتمارين رياضية ومشاهد مسرحية، من بينها نسخة عربية من حكاية عازف الناي(المزمار السحري). وبعد العرض، كتب أوين إلى والدته:
“استمتعنا جميعًا بالعرض، عدا أحد المسؤولين الحاضرين الذي تثيره الفكرة بحدّ ذاتها؛ فقد سحب ابنته من المدرسة قبل ثلاث سنوات عندما اكتشف أنهم يدرّسون الفتيات تمارين الإيقاظ البدني (الكاليستنكس).”
لم يكن الاحتفال مجرد عرض بهيج، بل علامة فارقة على تحوّلٍ اجتماعي طال حياة النساء السودانيات خارج حدود المنزل. فمنذ ثلاثينيات القرن العشرين كانت الحكومة تسعى جاهدَةً لإرساء التعليم النظامي للبنات، إلا أن المشروع اصطدم بعائقين رئيسيين: النقص الحاد في المعلمات المؤهّلات وثقافة الحريم الصارمة التي تحصر النساء والفتيات في الفضاء الخاص. كانت المعلمات تستقدم من الخارج، ولكن إخراج الفتيات من العزلة كان أصعب بكثير. في هذا الإطار، مثل احتفال 1944 م في النهود كان تتويجًا ليس لإنجازات الطالبات الأكاديمية فحسب، بل ولانفتاحهنّ الاجتماعي.
إذ رفضت الفتيات الصمت، وغنينَ ورقصنَ وتمرّنَ على تمارين رياضية، متحدّيات بذلك العُرف القائل إن جسد المرأة وصوتها ينبغي أن يختبئا. وفي المقابل، تحدّت الأمهات والجدات والحفيدات والعمةُ – ثلاثمئة امرأة – العزلة نفسها بحضورهنّ الحفل. وهكذا، تجاوزت الفتيات والأمهات حدود الكتب المدرسية إلى مساحةٍ للتجربة والسلوك الجديد.
بعد جيلٍ من افتتاح بابكر بدري أول مدرسةٍ للبنات في الرفاعة بسبعة عشر تلميذًة فقط، صار الالتحاق بإحدى مدارس البنات الحكومية نُخبةً مرموقة. ففي عام 1944، بلغ عدد المدارس الابتدائية الحكومية للبنات 62 مدرسة، إضافةً إلى مدرسة إعدادية وكليّة تدريبٍ للمعلمات. وكانت ثانوية البنات المنتظرة مقررةً للعام التالي. وارتبط القبول بالعمر والطبقة الاجتماعية ثم الجدارة. فاضطرّ بعض الآباء أحيانًا إلى تزييف أعمار بناتهم صعودًا أو هبوطًا، حسب الأماكن الشاغرة في الصفوف. وسهّل نقص شهادات الميلاد هذه الخدعة، إذ كان المعلمون يقدرون عمر الطالبة من خلال ظهور أسنانها الدائمة.
في مذكّراته اللاذعة، يعترف أوين بأن الانتماء إلى أسرة مرموقة كان “المفتاح الحقيقي” للحصول على مقعد في المدرسة: “ في بلدٍ تقليديٍّ تُقدَّر فيه مكانة المرء بمولده ونسله، فإن العدل الآلي الذي يزعم قائمةً على الامتحان التنافسي الخالص ليس مقبولاً أو مرغوبًا.” ومع ذلك، رسمت اللوائح أولًا البنات الحاصلات على شهادة ميلاد تثبت بلوغهنّ سبع سنواتٍ على الأقل (مما ساعد الخدمة الطبية في تعميم هذه الوثائق)، ثم أقرباء المعلمات والممرضات والقابلات، وأخيرًا “السكان المحليون الحقيقيون” الذين لا تحظى بناتهم ببدائل تعليمية في المدن الكبرى. بفضل هذه المعايير أو بحظٍ منّيح، استطاعت فتاةٌ أن تنال موطئ قدمٍ من بين آلاف المقاعد البضعِ آلاف في المدارس الابتدائية. وأكثر ندرةً كانت التسعين مقعدًا في كلية تدريب المعلمات التي أعدت أفضل الطالبات لمهنة التعليم.
ومن بين أبرز رموز هذا التقدّم، ظهرت ثِيابٌ مخططةٌ عُرفت بـ«أضلاع المعلمات» (Schoolmistresses’ Ribs)، فسُميت تيمُّنًا بمعلمات المدارس اللائي كن يلبسن أنماطًا مخططةً تبرز “أضلاع” القماش. لم تكن هذه أول ثِيابٍ تحتفي بالتعليم، فقد سبق أن ظهر “ثوب أضلاع الأطباء” تخليدًا لأول دفعة تخرّجت من كلية الطب عام 1928. أما الآن، فقد بات أضلاع المعلمات ترجمةً بصريةً لإنجازات النساء وخطوةً رمزيةً نحو الاحتفاء بتعليم البنات.
ومع ذلك، ظلّ التعليم النسائي نادرًا. ففي 1938، اجتمع أكثر من ألف خريج ثانوية من الرجال في أم درمان لتأسيس “المؤتمر العام للخريجين”، سعيًا “لرعاية مصالح البلاد العامة” و”التعاون الوديّ والطاعة” مع الحكومة. وبعد عامٍ، خاطبوا السكرتير المدنيّ بمطالبةٍ بإصلاحٍ شاملٍ للنظام التعليميّ، فندّدوا ببرامج الحكومة “الرجعية”، مستشهدين بأن نسبة تعليم الأولاد في السودان بين ستة إلى اثني عشر عامًا لا تتجاوز 6%، في حين تبلغ نسبتها في أوغندا أكثر من 33%. واستنتجوا أن :
“حتى لو ضُخّم عدد المدارس الابتدائية والإعدادية، فلن يرقَ إلى تطلعاتنا، ولن يضاهي التقدم المحرز في البلدان المجاورة”، ليعكسوا ترتيبًا عنصريًا يُسقط السودان دونًا عن مستعمرات أفريقية “أقل حضورًا”.
وجعل الخريجون من تأخر التعليم النسائي سببًا رئيسيًا في تخلّف الأمة، فكتبوا:
“إن تقدم البلاد معرقلٌ (مُعَطل) إلى حدّ بعيد بسبب جهل النساء السودانيات، فلا بد من توفير مدارس للبنات بقدر ما وُفِّر للأولاد، ورفع مستوى هذه المدارس لضمان إنتاج زوجاتٍ وأمهاتٍ صالحاتٍ قادراتٍ على تأسيس بيتٍ سعيدٍ والاعتناء بأطفالهنّ.”
وأشار الخريجون كذلك إلى أن الزوجة المتعلمة تستطيع معالجة كثير من مشاكل سوء التغذية وسوء المسكن والصرف الصحي داخل الأسرة، مما ينعكس على صحة الأمة واستقرارها. لكن المجتمع لم يتفق حول مدى ملاءمة التعليم العالي للبنات. ففي مجلة “كلية جوردون” قُرئت مقالات متعارضة، تنتهي إحداها إلى أن:
التعليم الابتدائي كافٍ للفتاة كي تربي أبناءها وتخدم زوجها وتفهم واجباتها الدينية، محذرةً من أن التعليم الثانوي سيخلق “مشكلات زواج لا حل لها” بين نساء متعلمات ورجالٍ أمّيون.
بينما اقتنع الكاتب عبد الله بشير بالعكس، فشدد على أن الزوجة المتعلمة تجعل البيت أسعد، وأبناءها بررةً، وتغدو بذلك “مساعدةً فعالةً لوطنها.”
وبينما تباطأ تعليم الرجال أحيانًا فانحاز إلى الفطرات التقليدية، انتشرت بين صفوة المتعلمين السودانيين رغبةٌ في شريكةٍ متعلمةٍ ومعاصرةٍ، فتنقل بعضهم للبحث عن زوجاتٍ مصرياتٍ أو سورياتٍ أو حتى أوروبياتٍ. وقد حذّر بابكر بدري من هذه الفجوة عام 1907، وحينما اعترفت الحكومة بنفسها عام 1937 بأن “الفجوة أصبحت لا يُردمها شيء”، أكّد تقرير لجنة لورد دي لا وَر أنّ توطيد أواصر الزواج كان من دوافع توسيع تعليم البنات.
إينا بيزلي الإنجليزية تردم الهوة
وألقت إينا بيزلي، التي وصلت إلى الخرطوم عام 1939 لإشراف تعليم البنات، بثقلها على هذا المسار؛ فقد حفّزت توسيع المدارس وتنوّع المناهج لتشمل العربية والرياضيات وفنون الطبخ ورعاية الطفل، وأدخلت الرياضة والفنون والحِرَفيات. وأطلقت برامج لربّات البيوت تضمنت تعليم القراءة والكتابة والحساب إلى جانب دروسٍ شعبية في الحياكة والطبخ.
ومن منبر إذاعة أم درمان، رسمت ملامح مهمتها التربوية: “قد تتمكن نساء السودان حينئذٍ من التعاون في حل بعض القضايا الاجتماعية الخطيرة التي، حسب بعض السودانيين، تعيقها غفلة النساء.” ولكن رؤيتها تجاوزت إعداد الأمّات؛ فقد أملت في أن يساهمنّ فعليًا في الحوار المدني ومعالجة شؤون الوطن.
كانت المناهج المبنية على توازن بين المهارات المنزلية والأكاديمية تضمن أن تبقى المرأة “مطوِّبةً” لزوجها بذكاءٍ ومعرفةٍ تُعزّزان البيت والمجتمع. وأشاد بعض الأزواج ببرامج الأندية النسائية التي عمّت بالسخرية الإيجابية:
“كانوا سيعلِّموننا كيف نكوي البناطيل الأوروبية!”
غير أن الإعلام المستورد من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط رسم معايير جمالية جديدةً، فتحمس بعض الرجال لفتاةٍ لا تشوب وجهها آثار الختان الفرعوني ولا ندوب الشفاه، تريد أيضًا رفيقةً تشبه كلاراج بوي أو غريتا غاربو. وفي المسائل العملية، حرّكت الحملة ضد الختان وتعليم الخياطة والدعوة للنظافة هِمم الأسر لتسليم بناتهم للمدارس الحكومية.
بهذه الرؤية المتكاملة – التعليمية والاجتماعية والثقافية – قادتها إينا بيزلي من مشرفةٍ إلى مديرةٍ للتعليم النسائي حتى أواخر الأربعينيات، فكانت بحقٍّ من بنات “أضلاع المعلمات” الحيّة: ركيزةً لنهضةٍ رسمت معالمها بأناملٍ سودانيةٍ وبروحٍ إمبراطوريةٍ إصلاحية.
الحملة ضد الختان الفرعوني
عندما كانت أجساد الفتيات الصغيرات تُرصّ في الفصول الدراسية، كنّ يخضعن لدروس إضافية في التحضر وصياغة الذات. مثل أقرانهن، شعرت بيزلي بالرعب حين تعرّفت على (طقس ختان الإناث)، وبالتعاون مع إيلين هيلز-يونغ، مديرة مدرسة تدريب القابلات الجديدة، أعدّت محاضرات في هذا الشأن لجميع مستويات تعليم البنات. أكّدت الدروس على المخاطر الصحية مثل العدوى المتكررة، والألم أثناء الجماع، والعقم، وصعوبات الولادة. وتخلّلت هذه الشروحات أيضًا مواضيع التقدّم الوطني والأمومة والأخلاق. في دليل لدرس مخصَّص لفتيات الصف الرابع الابتدائي، كُتِب:
«هل تعلمن أن السودانيين لا يمكن أن يرتقوا إلى مصاف الأمم الأخرى طالما استمر هذا العرف؟ … وهل تعلمن أن أبناءكنّ وأحفادكنّ يصغُرون به؟ وهل تعلمن مدى صدمة وامتعاض الناس في الدول الأخرى حين يسمعون عن هذا العرف في بلدكنّ؟» كان الهدف من المقارنات السلبية مع الأمم الأخرى تحفيز التغيير.
وذكرت إحدى المحاضرات: «من الضروري أن تدرك الفتيات المتعطشات للعلم أن الختان بأي شكل لا وجود له ولا يُعرف به في غالبية الأمم المتحضرة — مثل أوروبا وأمريكا». وُصفت النساء المتحضّرات بأنهن «عفيفات بالقوة الأخلاقية، لا بالقوة الجسدية المؤلمة». وغالبًا ما ذُكر، خطأً، أن الختان الفرعوني قد انتهى حتى في مصر «لأن المتعلمين أدركوا ضرره». اللافت أن لا منهجًا مقابلاً وُضِع في مدارس الأولاد حول الصحة الإنجابية أو مخاطر الختان..

Miss Elaine Hills Young (1895-1983)
فحمَّلت السلطات البنات وحدهنّ عبء الإصلاح، معتبرةً أن عاداتهنّ البربرية وأجسادهنّ المشوّهة هي التي تعرقل تقدّم السودان.
لا نعرف كيف ترجمت المحاضرات فعليًّا في الفصول، أو ما إذا كانت المعلمات البريطانيات والسودانيات يستعملن كلمات مثل «صدمة» و«اشمئزاز». لكن من المؤكد أن الطالبات شعرن بصدمتهن ورعبهن وحيرتهن عند سماع هذه الدروس. وعلى الرغم من تردّد المؤرخين في تحليل نفسي لموضوعاتهم، فإن علماء الأنثروبولوجيا يفحصون العواطف كمظهر جماعي — مجموعة من ردود الفعل البنيوية ثقافيًّا على العالم الخارجي. فالعواطف هي نموذج مجسّد للمعرفة؛ فهي أفعال وردود أفعال، فضلاً عن كونها شغفًا.
عندما واجهت الطالبات العواطف السلبية للمستعمرين، كان لهنَّ خبرة أخرى في أجسادهن. فمعظم الفتيات اللائي تعلمن أضرار الختان قد خُتنَّ بالفعل، دون عمر محدد للطقس، وإنما عند «سن الرشد» عادةً قبل البلوغ، لكنه كان تقريبًا. ففي عام 1945، قرب نهاية عمل بيزلي في السودان، أجرت المعلمات مسحًا صغيرًا في بعض مدارس أم درمان حول مدى انتشار الختان. في مدرسة ابتدائية، فُحِص ثمانون فتاة في الصفين الأول والرابع. وكانت عشر فتيات في الصف الأول، نحو ست سنوات، غير مختونات، وخمس فتيات في الصف الرابع، في العاشرة من العمر، لم يخضْن الطقس بعد — لكن كان من شبه المؤكد أن يخضعن له لاحقًا. أمّا جميع طالبات المدرسة المتوسطة وكلية التدريب فكنّ مختونات.
فكيف كان يُتوقَّع أن تردَّ الفتيات والشابات على انتقادات الإمبرياليين القاسية لأعضائهنّ الخاصة؟
تذكر بيزلي أن طالبات كلية إعداد المعلمات خسرن بعض خجلهن عند مناقشة الختان، «ويبدو الآن أنهن يشعرن بالأسى لأنهن خُتنَّ. فلا شيء بوسعهن فعله لتغيير آراء الكبار، لكنهنّ سيبذلن قصارى جهدهنّ في المستقبل». لا ريب أن بعضهن شعرن بالخجل والغضب تجاه أجسادهن المقطوعة. وأسّسن لاحقًا نشاطات مدافعة عن إنهاء الختان.
لكن كثيرات واجهن صعوبة التوفيق بين حقيقة أجسادهنّ وبين حجج المصلحين، لأنهنّ كنَّ أدرى من الإمبرياليين بأن الختان جزء من منظومة معقدة للعلاقات الجندرية والجنس والتكاثر.
وفيما حرصت الطالبات على الظهور متحضرات في نظر العالم، بقيت القيم المحلية المتعلقة بالعفة والأدوار الاجتماعية تحكم حياتهن.
ولإيقاف الختان كان لا بد من تحوُّل جذري في حدود العالم الاجتماعي للمرأة. إذ وجدت كل فتاة فسحةً بين وعود التقدّم غير الملموسة والشعور بالانتماء والمسؤولية المطبوعين بالفعل على جسدها.
كان برنامج بيزلي الحماسي مُتسقًا مع جهود الحكومة السودانية المكثفة للقضاء على الختان الفرعوني. ففي عام 1937، وبعد ستة عشر عامًا من التجوال في أنحاء السودان لتجنيد الممرضات والقابلات، تقاعدت مابل وجرترود وولف وعدن إلى إنجلترا بجعبةٍ لا تكاد تتجاوز ما جئن به، بعد أن تبرَّعن بمعظم أثاث منزلهما وصورهما بإطاراتها لموظفيهما.
وتولّت إيلين هيلز-يونغ، القابلة السابقة بمستشفى الخرطوم، منصب مديرة مدرسة تدريب القابلات لما تتحلّى به من عدم تسامح مع «التقاليد المتخلّفة». وعندما لاحظت في أول يوم لها أن قابلة في المدرسة كانت تجري ختانًا معدلًا باستخدام موسَّى معقّمًا، ويودٍ، وغسيل متكرر للأيدي، وجدت المشهد «مقززًا بما فيه الكفاية» وأعلنت منع أي ختان بجميع أشكاله.
علّمت تلميذاتها الأساليب الأكثر أمانًا لفتح ندوب الخاضعات للختان أثناء المخاض، لكنها لم تدرّبهن على ختان معدل نظيف، كما كانت تُوصي سابقتها. وبهذا ظفرت بموجّهٍ ثالث: قابلات متخصّصات في النظافة والطب الحيوي، لكنهن يفتقدن الخبرة في رعاية الأجساد المختونة.
جاء هذا الانقلاب الحادّ في ممارسة القابلات في وقتٍ سياسي حساس.
ففي عام 1936، منح معاهدة أنجلو-مصرية جديدة لبريطانيا هامشًا دبلوماسيًا للتدخّل الأعمق في شؤون السودان من دون قلق من شريكها المشترك. ثمّ في 1939، ترقّى دوغلاس نيوبولد، المسؤول الذي اهتم منذ زمنٍ طويل بموضوع ختان الإناث، إلى منصب الأمين المدني، فاتّسع نطاق نفوذه.
وفي العام نفسه، أصدر مفتي السودان، أعلى سلطة دينية في البلاد، بيانًا في جريدة النيل يشرح فيه أن الختان «مستحبّ» لكنه غير واجب، وأنه يكفي فيه قطع جزء من البظر.
وبعد عشرين عامًا من انتظار بذور التغيير من الأسفل، بدأت الحملة أيضًا من الأعلى. وانضم إلى المصلحين الرسميين في حملتهم اثنان من أبرز الزعماء السياسيين والدينيين في السودان: السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني.
كان عبد الرحمن المهدي، الابن اللاحق للمهدي وقائد طائفة الأنصار، يُنظر إليه في البداية كتهديد سياسي للإمبراطورية، لكنّه عندما انتقد الانتفاضات القومية عام 1924م ودعا إلى التعاون مع البريطانيين تمهيدًا للاستقلال، صار من أهم حلفاء الحكومة في كسب التأييد الشعبي. أما منافسه علي الميرغني، زعيم الطريقة الختمية، فقد رأى فرصة لتعزيز دوره فدعّم اتحاد السودان بمصر. واستغل المسؤولون الإمبرياليون صراع الرجلين وطموحاتهما لتحقيق توازن دقيق يبقي أنصار كل منهما منضبطين على أمل مكاسب مستقبلية.
في ما يخص الختان، أضفى زعيمان كهذَين وزنًا سياسيًّا وقبولًا مهمًّا على حملة الحكومة. فاقتَسَمَا كتابة تمهيدين لكتاب حكومي عن أضرار الختان الفرعوني الجسدية والاجتماعية: عبّر عبد الرحمن المهدي عن «عنايته بتثقيف ورفع مستوى النساء السودانيات»، فتكون بانتهاء الختان البلد أفضل.
في حين أشار الميرغني بحكمة إلى أن لكل البلدان عاداتٍ إيجابية وسلبية، وأن «الختان الفرعوني سيختفي مع غيره من العادات السيئة بالتربية والتنوير». كانت هذه النغمات مألوفة؛ فكلاهما ربطا صحة أجساد النساء بقوة أمتهن. ومع دعم القادة المحليين وتكتيكات مدرسة تدريب القابلات، بدا الوقت مناسبًا للتحرك الحكومي المباشر.
في مايو 1945، اجتمع المجلس الاستشاري الحكومي، المكوّن من وجهاء وتجّار وموظفين سودانيين، مع بعض المسؤولين الإداريين بمن فيهم إينا بيزلي، وأقرّ بالإجماع قرارًا يصف الختان الفرعوني بأنه «ممارسة قاسية ووحشية» و«أثر من آثار أيام الجاهلية ما قبل الإسلام». ثمّ أقرّ قرارًا ثانٍ يطالب بتشريع يحظر الختان الفرعوني بأغلبية 18 صوتًا مقابل 9. وبعد عام، في فبراير 1946، عدّل قانون العقوبات ليقرّ بأن «من يسبب عمدًا أذى للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة يكون قد ارتكب ختانًا غير مشروع»، مع الإبقاء على حق «إزالة الجزء الحر البارز من البظر». هكذا وُضِعت تحت طائلة القانون عقوبتان: الاقتصاص الشديد (الختان الفرعوني) والعقدة الخفيفة (الختان السُّنّي).
صيغ القانون ليجرِّم أكثر أشكال الختان ضررًا، لا ليُنهي الختان عمومًا. وأقرّت الغرامات والسجن (50 جنيهًا و7 سنوات لكل من يجرِّم الختان الفرعوني، و20 جنيهًا و6 أشهر لكل من يعلم بالعملية ولا يبلغ السلطات أو يساعد فيها).
لكن سرعان ما اتضح أن المصلحين أخطأوا قراءة مزاج الشعب، وخصوصًا نسائه.
فخشيًا من العقاب، أسرعت كثير من الأمهات إلى ختان بناتهن، كنَّ في بعض الحالات لا يتجاوزن ثلاث سنوات. وتواطأت القابلات، سواء الخريجات من مدرسة تدريب القابلات أو الديّات، سرًا في إجراء الختان الفرعوني. وبعضهن من باب الحذر كنَّ يقمن بختانٍ معدل يزعمنه أمام المراقبين، ثم يَرجِعن بعد شهر لإكمال الختان الفرعوني.
وأُمسِكت قابلة أثناء ختانها طفلة، فجرّها ضابط صحي بريطاني أمام الناس وصفعها على وجهها.
في إنجلترا، تلقت مابل وجرترود وولف رسالة من ماري كراوفوت (التي كانت أسئلةٌ مصيرية لها علّمت مدرسة تدريب القابلات) تفيد بأن الختان الفرعوني يُجرى الآن «على نطاقٍ واسع».
فأجابتهما مابل بمرارةٍ نادرة بأنها ليست مندهشة لأن القانون الجديد زاد من انتشار الممارسة: «أشعر بأنّ خدمات وزارتنا كانت قاسية معنا في بعض الأوقات، خصوصًا العام أو العامين الماضيين… حين بدا أن خدمة الصحة السودانية تتلذّذ بإيذاء المشاعر والاستخفاف بجهودنا ومدح مَنْ تفضّل عليها»، مبرزةً أنها أثبتت جدارتها ولوّل هيلز-يونغ لم تثبت بعد.
مع ذلك، لم تكن هيلز-يونغ في السودان حين سُنّ القانون. ولو بدافع خبرتها المحدودة، فقد أساءت تقدير صعوبة تغيير أجساد وثقافة النساء. فما إن صدر قانون حظرُ الختان الفرعوني حتّى وثبّت العديد من الأمهات ختان بناتهن خشية العقاب.
في سبتمبر 1946، أخبرت قابلةٌ في رفاعة السلطات بأن أمًا محليّة ختنّت ابنتها. وحُكِم على الأمّ بالسجن أربعة أشهر، لكن احتجاج القرويين على قسوة العقوبة استدعى إطلاق سراحها مؤقتًا لانتظار إعادة المحاكمة.
وعندما أيدت المحاكم الحكم وأراد الضباط نقلها قسرًا إلى السجن ليلا، خطط سكان رفاعة للتظاهر. وفي صباح السبت عبر ألف رجل النهر مع حمل بعضهم العصي، واقتحموا مركز الشرطة، وقطَعوا خطوط الهاتف، وكسروا الأثاث، وحطّموا النوافذ، وهدّدوا المندوب المحلي والقابلة التي أبلغت عن الفصل. لاذ رجال الشرطة بتأييدهم الحاشد، فلم يقدروا على ردِّهم. ثمّ طُلبت تعزيزات عسكرية من الخرطوم فضَضّت الحشد، وأعادت الأمّ المسكينة إلى بيتها.
لم تكن خطوط الصراع في رفاعة واضحة تمامًا: فقد رأى بعض المحتجين أهمية الختان الفرعوني الأخلاقية، واعتبر آخرون التظاهرات فرصة للاعتداء على الحكم الإمبريالي. لكن السياج الدقيق الذي يمرّ في عمق الحدث هو صراع سيادة الجسد الأنثوي: فالقابلة التي أبلغت هي نفسها وكيل الدولة، فاتخذت على عاتقها سلطة الأبوين (متأخرةً) على جسد الطفلة، فتعرضت لهجوم الجيران.
صاحب هذه الواقعة محمود محمد طه، مؤسس حركة الإخوة الجمهوريين الإصلاحية الدينية، الذي كان ضد الختان الفرعوني لكنه رفض سلطة البريطانيين على أجساد نساء السودان.
فقد رأى أن الحقوق الثقافية شبيهة بالحقوق السياسية، وأن إيجاد قانون يفرض حظر الختان الفرعوني هو انتهاك للسيادة الوطنية. ومن وجهة نظر الوطنيين مثله، الحق في معايير التحضر والأخلاق وتقدير الضرر لا يملكه سوى السودانيين أنفسهم.
وفي النهاية، كانت نساء السودان اللواتي رفضن التنازل عن سلطتهن على أخصوصياتهن الحميمية. فلم تقتنع النساء المحليات بمحاضرات الصحة والتقدّم، ولا بفتاوى رجال الدين، ولا بالقوانين التي قيل إنها ستحررهنّ من عادة قمعية، إذ وضعت أجسادهنّ تحت مراقبة أشد. فقد واصلن أداء طُقوسهنّ على هواهنّ. وبعد ثلاث سنوات من سنّ القانون، أبلغت مورييل مكباين، معلمةً في مدرسة ود مدني الإعدادية للبنات، إينا بيزلي بأنهن:
«اتفقن بالإجماع على أن نساء المدن والقرى يمنحن تأييدًا شفهيًّا لختان “السنّة” عندما يُسأَلْن، لكنهن لا يعتزمن ولا ينوين تغيير نوع ختانهنّ… لا يمكن تحقيق أي تقدّم حقيقي حتى تصبح الفتيات المتعلّمات حاليًّا جدّات».

Dr. Ina M Beasley (1898–1994)
بالطبع كان لشرائحٍ صغيرة من النساء رأي مختلف، وقد اعتنقن الدروس وصِرْن ناشطات مكّلفات بإنهاء الختان أو تلطيف أشكاله، لكن لدى الغالبية استمرّ الختان الفرعوني بلا انحسار ملحوظ، ودون تطبيقٍ جاد للقانون. وقد بلغ الفشل ذروته حين فشل المصلحون الذكور والإداريون في تغيير مقاييس احترام النساء وأجسادهن بتخطيطٍ يتناسب مع منظومتهن الثقافية. ولذلك، على الرغم من مواءمة الإصلاحات مع نساء السودان، فقد ظل الانقطاع الحقيقي ممكنًا فقط حين يجري بناء أي تغيير «بشروط النساء» وبلسانهنّ.
في أعقاب هذا الفشل، سيكبر جيل البنات المتعلّمات في مدارس الدولة ليؤيد نهجًا الإصلاحيًا من داخل المجتمع، ولن يرجع إليهن الدرس القاسي عن أبدانهن ولا قوانين المجلس الاستشاري ولا أحكام السجون. لقد بلغ التدخّل الإمبريالي في أجساد النساء حدَّه الأقصى.

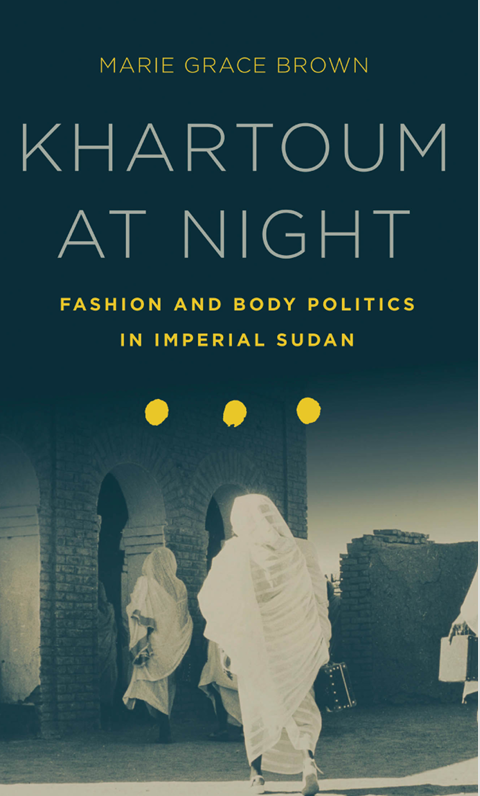
اترك تعليقاً