بقلم: ماري غريس براون
ترجمة: أيمن هاشم
داخل فضاء (الحريم)
التغلغل إلى العقول والأجساد كان يتطلب اجتياز أسوار الحريم (الجدران المشيدة حول حوش الحريم). في المخيال الغربي، يثير مصطلح “حريم” صورًا لغرف معزولة تعج بنساء مبهورات ينغمسن في الملذات الحسية. لكن الحريم في الواقع نظامٌ للتنظيم الاجتماعي والمكاني يفصل بين العام والخاص. الأهم أن الرجال والنساء على حد سواء يراقبون حدوده. هكذا، لا يكون الفصل بين الجنسين قمعًا بل “اعترافًا بحق كل جنس في عالم اجتماعي خاص، يُلزم الآخر باحترامه وحمايته”.
زواج الموارد والدماء
في النصف الأول من القرن التاسع عشر، دار عالم المرأة الشمالية السودانية حول الإنتاج المنزلي والشراكة الإنجابية. الزواج اتحادٌ اقتصادي قبل أن يكون لقاءً عاطفيًا. تمتد الاحتفالات من 7 إلى 40 يومًا، يمولها العريس وعائلته بالكامل. حتى في أبسط الأحوال، تتطلب طقوس الزهور مهرًا غاليًا، وتجهيز منزل جديد بسرير “عناقريب” ذي نقوش نحاسية، وصناديق خشبية لحفظ التوابل (حُقّ)، وأكواب القهوة الشهيرة.
ليست المُتعة الجنسية هدفًا لهذه الطقوس. فبسبب الختان الفرعوني، قد يتعذر الإيلاج الكامل لشهور. هنا، يُثبت الرجل رجولته عبر توفير الموارد المادية، بينما تتحول هدايا العروس إلى “حقيبة” ترمز لانتقالها من بيت الأب إلى حماية الزوج.
الجسد كسجل اجتماعي
تحمل جسد الأنثى بصمات هذه التبادلات. قبل الزفاف، تُخَضَّب الشفاه بالحناء، وتُثقب الأذنان، وتُزال شعرات الجسد – علاماتٌ حصرية على النساء الناشطات جنسيًا. في الخفاء، تضمن ندوب الختان – المُجرى قبل سنوات – “طهارة خصبة” عبر إغلاق الرحم رمزيًا، مما يضمن – حسب الاعتقاد – نقاء الأبناء.
كما تروي بيغي فيدلر، الممرضة البريطانية التي عملت بمستشفى الخرطوم في منتصف القرن العشرين:
“رغم آلام الولادة، كان الإنجاب معنى حياتهم. العقم كان كارثة، ووجود البنات فقط شبه كارثة!”.
التشذيب الجنسوي: صناعة الجندر قبل الجنس
في الثقافة السودانية، لا يحدد الجنس البيولوجي الهوية الجندرية، بل العكس. يشرح الأنثروبولوجي جانيس بودي: “الختان لا يلغى الغموض الجنسي، بل يحوّل الجسد إلى وعاء أخلاقي للدور الاجتماعي”. بإزالة البظر (الذي يُعتبر ذكرانيًا) وقلفة القضيب (الأنثوية)، يصبح الجسد ناضجًا لاستلام مهامه.
شبكات الخصوبة الخفية
رغم ظاهر العزلة، يتشابك عالم الحريم عبر شبكة من الحرفيات:
المُشَطَّات: حارسات تسريحات “المُشَط” المعقدة التي تستغرق أيامًا. خلال جلسات التمشيط الطويلة، تنتقل الأخبار بين البيوت، وتُسَرب أسرار العلاقات الزوجية.
الدايات: قابلات يقدن طقوس الولادة، ويحصلن كمقابل على قمح وصابون وتوب أبيض.
عبيد المنازل: رغم قرار 1925 بتحرير المولودين بعد 1898، ظلت نساء يُربين أطفال السادة مقابل البقاء في ظل عائلات أسيادهن.
طقوس الزار: أنثروبولوجيا الاحتجاج الأنثوي
عندما تعجز الزوجة عن مواجهة إهمال زوجها، تستدعي أرواح الزار. هذه الكيانات – ذات أصول إثيوبية حسب المعتقد – تحتجز جسد الأنثى مقابل الاهتمام والهدايا. في حفلات الطبول الصاخبة، تُجبر الأرواح الزوج على شراء توب جديد وعطور فاخرة، وكأنها تقول: “لا تستهين بخصوبتها ولا قيمتها“.
الإمبراطورية تدخل عالم الحريم
مع افتتاح مدرسة القابلات 1921، بدأت ممرضات بريطانيات مثل “الذئبتين” مسز وولف باختراق هذه الشبكات. حمَلن معهن مجسمات أجنة وأدوات تعقيم، وحاولن استبدال حكمة الدايات بعلوم التوليد الحديث. لكن تدخلهن واجه تناقضًا: كيف تُقنع امرأة أن “طهارتها” التقليدية خطرٌ على خصوبتها، بينما الإنجاب نفسه هو مصدر قوتها الاجتماعي؟
هكذا، تحول الحريم من فضاء العزلة إلى ساحة صراع بين أنساق ثقافية متضاربة، حيث تُختبر حدود الإصلاح الاستعماري أمام صمود أنثروبولوجيا محلية متجذرة.
بذور الثورة والتغيير
لم تكن البداية مبشرة في البحث عن طالبات لتلقي تدريب القبالة. رغم آمال المسؤولين الكبار، أدركت مابل وجيرترود ضرورة العمل ضمن الممارسات التقليدية للقابلات بدلًا من مواجهتها. هكذا، توجهت مس مابل للبحث عن طالباتها الأولى بين الدايات الممارسات وبناتهن. نصحها مسؤولٌ بأن الدايات المخضرمات – المُلمَّات بأساليبهن في الولادة – قد يترددن في الخضوع لتدريبٍ يستغرق أشهرًا، لكنهن “ربما يوافقن على 4-6 أسابيع، ليتعلمن أساسيات النظافة ويعملن بها”.
بدأ الفصل الأول في يناير 1921 بتلميذتين فقط: نورا بنت عمر (داية سبعينية)، وزوجة البواب التي فرت مع زوجها فور انتهاء تدريبها. بعد شهر، انضمت إليهما عزيزة بيرسي (68 عامًا) ومستورة خضر (بدون خبرة).
في تقريرها السنوي الأول، اعترفت مابل:
“معظم الدايات رفضن الإقامة بالمدرسة، وشككن في خبرتي، كما خافت المريضات من انتهاك تقاليدهن”. لم يكن الشك في كفاءة الأختين فحسب، بل في شخصيتهما أيضًا: فكونهما عازبتين بلا أطفال، رأت الدايات أنهما تفتقران لفهم تعقيدات الولادة.
منهجٌ عملي بلمسة إبداعية
صممت مس مابل برنامجًا تدريبيًا صارمًا مدته ستة أشهر، مع إقامة كاملة. وفرت المدرسة السكن والمواصلات والزي الموحد ومخصصات نقدية بسيطة. اجتمعت الطالبات في المطبخ، وتبادلن الأخبار أثناء طهي وجبات جماعية من الحليب والخبز والفول.
في الصف، تعلّمن قياس الحرارة، وتضميد الجروح، ورعاية ما قبل وبعد الولادة – دون تدريس القراءة أو الكتابة. عوّضت مابل الأمية بأساليب مبتكرة: التعرف على الأدوية بالرائحة والطعم، التدرب على الخياطة بإطارات السيارات القديمة، واستخدام دمى أطفال أوروبية كنماذج تدريب.

قصص القابلات
كشف سجل القابلات صعوبة الجمع بين المهارة والأخلاق. إحدى الخريجات المبكرات وُصفت بأنها “عاملة منظمة – تستطيع قراءة الترمومتر أحيانًا”، بينما نُعتت أخرى بأنها “بطيئة ومُعرضة للعبوس”. حتى الواعدات كن عرضة للانتكاس: خريجة 1926 التي تحولت لـ”فتاة أخلاقها مُنهارة” بحلول 1930، وأخرى وُصفت بأنها “ضخمة جدًا لدرجة تعيق عملها”.
لم تكن الأحجام الجسدية هي المشكلة، بل المواقف. كما علقت إيلين هيلز-يونغ (خليفة آل وولفز): “صعب غرس روح الخدمة في هؤلاء الفتيات. قلة منهن ممرضات بالمعنى الحقيقي”.
واجهت المدرسة تحديًا آخر: رفض تدريب “السوداوات” – النساء من أصول جنوبية أو عبيد سابقين. مصطلح “سوداوية” (مشتق من العربية للسواد) حمل دلالات عنصرية، ارتبطت بالعبودية والهمجية. رفضت مابل مرشحةً قدمها مفوض منطقة الخرطوم شمال واصفة إياها بـ”جارية عادية”، مُحيلة إياها لسجن النساء حيث “الأجساد والأخلاق مُختلّة”.
تعكس هذه العنصرية سياسةً أوسع. بعد احتجاجات 1924، أقرت الإدارة البريطانية “سياسة الإغلاق الجنوبي” عام 1929، عازلةً جنوب السودان عن التأثر بالمد القومي الشمالي. مُنع التجار الشماليون، وأصبحت الإنجليزية لغة رسمية. هكذا، حُرمت نساء الجنوب – حيث لا يُمارس الختان الفرعوني – من خدمات مدرسة القبالة، تاركاً صحتهن للبعثات التبشيرية.
من ولادة الحبل إلى ولادة الماكينتوش (ثورة الوضعيات)
شكلت ولادة “الماكينتوش” على الظهر – باستخدام شرائح بلاستيكية – صدمة ثقافية. رغم أن بعض الأمهات تباهين بأطفال “أبناء الماكينتوش”، ارتابت أخريات من كون البلاستيك جلد خنزير! ساهمت النخبة في كسر الحاجز:
زوجة الزعيم الديني السيد علي الميرغني أنجبت أطفالها الثلاثة بواسطة مابل، مُرسخةً موضة جديدة.
ست بتول: أيقونة الثورة الصامتة
تمثل ست بتول محمد عيسى – خريجة مدرسة رفاعة للبنات – نموذج الخريجة المثالية. رغم هجر زوجها لها أثناء الحمل، التحقت بمدرسة القبالة بحثًا عن الاستقلال. وصفها ال وولفز بـ”البطيئة في التدريب”، لكن إصرارها جعلها لاحقًا مدربة ناجحة. أصبحت ست البتول أشهر مُحاضرة ضد الختان الفرعوني، مستخدمة خطابًا يجمع بين النظافة الإسلامية والروحانيات المسيحية:
“كل طفل تُخرجينه من الظلام للنهار هو هبة إلهية، كوني جديرة بها“.

الختان “الحكومي”: مفارقة تاريخية
لم تحظر ال وولفز الختان، بل طوّرنه. قدمتا شكلاً “مُعقلنًا” يُبقي على أجزاء من الشفرين والبظر، تحت شروط تعقيم صارمة. سُمي “الختان الحكومي”، في تلميحٍ لدعم السلطة الاستعمارية – المنافسة للنموذج “الفرعوني” المصري. رغم ذلك، استمرت معظم النساء في تفضيل الختان الكامل، كرمز للهوية الشمالية.
هكذا، بينما غرست مدرسة القبالة بذور ثورة صامتة – ربما قد يكون لاصوت مسموع لها، لكنها بدأت تزيح الطبقات الأولى من مياه المستنقع” بأنامل القابلات، ظلت أجساد النساء ساحةً لصراع الهويات: بين تقليد يُعاد اختراعه، واستعمار يتنكر في ثوب الإصلاح.

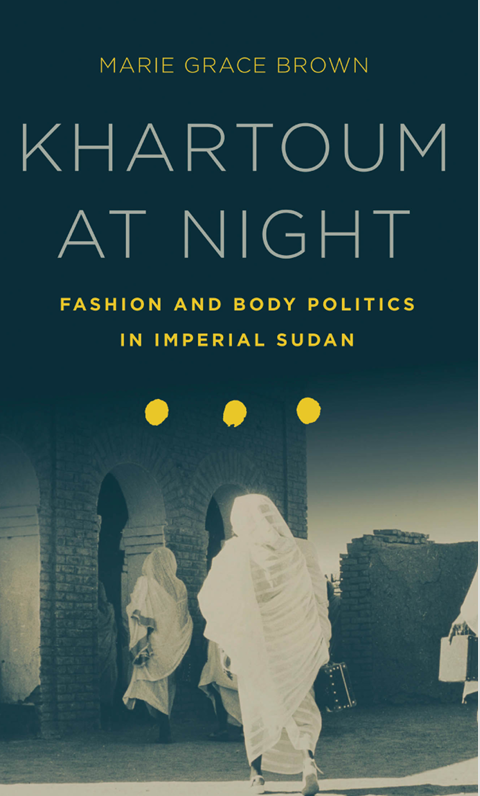
اترك تعليقاً