Shadows on the Sand: The Memoirs of Sir Gawain Bell -published in 1984
ترجمة لمقتطفات من كتاب (ظلال في الرمل ) مذكرات السير غوين بيل
غرب السودان
(كردفان وجبال النوبة، ١٩٣٣–١٩٣٨)
وهكذا، في صيف عام ١٩٣٣ مع نهاية إجازتي الأولى، وجدتُ نفسي مُعينًا في كردفان، التي اختلفت عن كسلا بشكل رئيسي لأن مناطقها الجنوبية كانت أقرب إلى خط الاستواء، وبالتالي أقل جفافًا وأكثر زنجية من الطابع العربي. لكن مثل كسلا، كانت تقع على طريق الحج المباشر من غرب أفريقيا إلى مكة، مما جعلها نقطة التقاء بين العالمين الأفريقي والعربي. تفصل مسافة ٤٥٠ ميلًا بين حدود كردفان الشمالية والجنوبية. امتد الحد الشمالي على طول خط العرض ١٧، بينما حدد النهر الغزالي الجنوبي الحد الجنوبي عند خط العرض ١٠. كان الجزء الشمالي من الولاية يتكون من كثبان رملية وصحراء، موطنًا لقبائل بدوية تمتلك الجمال. أما الجنوب فكان سلسلة من الكتل الجرانيتية الرمادية، ترتفع إلى ٢٥٠٠ قدم فوق السهول؛ كتلةٌ فوضوية من الصخور الضخمة المليئة بالكهوف، تسكنها قبائل وثنية. كانت هذه القبائل متنوعة في المظهر الجسدي، وتتكون من أكثر من خمسين مجموعة عرقية تتحدث عشرين لغة أو أكثر وتتبع عادات متنوعة.
كانت هذه هي جبال النوبة (التي كانت في وقت ما ولاية إدارية مستقلة عاصمتها تلودي، قبل أن تُدمج مع كردفان في أواخر عشرينيات القرن العشرين). بين هذين الجزأين الشمالي والجنوبي من الولاية، امتد حزام عريض من الأشواك، أرضٌ يسكنها مزارعون بدوٌ ومستقرون يتحدثون العربية ويتبعون الثقافة والعادات العربية إلى حد كبير. في وسط الولاية، عند المحطة الغربية لخط السكة الحديد من الخرطوم، تقع الأبيض، المركز الإداري والتجاري. كانت مساحة كردفان تعادل تقريبًا ألمانيا ما قبل الحرب، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة.
قرر “نيوبولد” إرسالي إلى جبال النوبة، لكن كبداية، قضيت شهرين في الأبيض. هنا، اكتسبت خبرة في عمل الولاية ككل، وفكرة عما كان يفعله المُربون والبيطريون والزراعيون والأطباء ويطمحون لتحقيقه. كان لديهم عدد قليل من الممثلين المحترفين في المناطق، واعتمدوا على الإداريين لمراقبة عملهم.
كانت الأبيض مكانًا جذابًا، باردًا وأخضر في منتصف موسم الأمطار. كان هناك المعسكر الذي يضم مقر الولاية، مبنىً طينيًا واسعًا يعود إلى القرن التاسع عشر لا يزال يحمل آثار رصاصات حصار قوات المهدية عام ١٨٨٣. كانت هناك البلدة عامرة بأحيائها السكنية والتجارية ذات الطابق الواحد، المبنية من الطوب اللبن في المناطق الأفضل، ومن أكواخ القش في الأحياء الفقيرة. كانت الشوارع المستقيمة المبطنة بالأشجار عريضة ورملية. ومنفصلًا عن البلدة الرئيسية، حيث كان حي غرب أفريقيا وعاش فيه عشرة آلاف نيجيري تحت سيطرة زعيمهم اليومية.
في عام ١٩٣٣، تألفت جبال النوبة من منطقتين إداريتين: الجبال الغربية والجبال الشرقية. كنتُ مُتوجهًا في رحلتي إلى الجبال الشرقية، التي تعادل مساحتها اسكتلندا وجزرها، ويقطنها ربع مليون نسمة. كان المقر الإداري في رشاد، مع مراكز حكومية في مكانين آخرين: دلامي وتلودي. في رشاد، كان “جيفري هوكسورث” البالغ ٢٨ عامًا المسؤول العام، بمساعدة “روبن إيليس” الذي كان مجدفًا في فريق كامبريدج لثلاث سنوات وقاده للفوز عام ١٩٢٩. في دلامي، كان المأمور “محمد عبد الرازق”.
على بعد ١٥٠ ميلًا جنوبًا، تقع تلودي، رحلة يوم طويل بالشاحنة في الجو الجاف، بينما في الأمطار لا يمكن الوصول إليها إلا بالخيول والبغال، وهو ما يستغرق أسبوعًا تقريبًا. كانت تلودي محطتي. لم يكن هناك مسؤولون بريطانيون آخرون سوى: مفتش زراعي ومهندس مسؤول عن معمل حلج القطن. نظرًا لكثرة تنقلاتنا، نادرًا ما التقينا بعضنا أكثر من مرة كل أسبوعين.
منذ الغزو التركي-المصري للسودان عام ١٨٢١ حتى الإطاحة بالنظام بعد ستين عامًا، شكلت جبال النوبة محمية لصيد العبيد، حيث استفادت الحكومة والمؤسسات الخاصة على حد سواء. “إغناطيوس بالمي”، تاجر نمساوي مغامر، قضى عامين في كردفان بين ١٨٣٧ و١٨٣٩، وكتب وصفًا مروعًا للفظائع التي ارتكبها النظام. بينما سُيق آلاف العبيد البالغين إلى مصر في ظروف قاسية، كان مصير الصبية المختارين ليكونوا حراسًا وخدمًا في حريم القاهرة أسوأ. تم إجراء عملية الإخصاء في الأبيض بواسطة شيخ خبير. كان الضحية مُثبتًا على الأرض بأكياس رمل، تُقطع خصيتاه بموس، ويُستخدم الزبدة المذابة لوقف النزيف، ثم تُلف الألياف النخيلية كضمادة. نجا نصف الضحايا فقط، وقليلون منهم وصلوا مصر، حيث بيعوا بأسعار تفوق العبيد السليمين.
تحت ضغط الغارات المنظمة، انسحب النوبة من السهول إلى معاقل جبالهم، مدافعين بشجاعة عن أنفسهم ضد المهاجمين المسلحين. بنوا قراهم بموقع دفاعي، وأتقنوا استخدام السكاكين والرماح، وشيدوا جدرانًا عبر الوديان لإعاقة الفرسان، وزرعوا منحدرات التلال ببراعة. تعرضوا للاضطهاد، فطوروا خوفًا من الحكومة والعرب، واستقلالية جعلت إقامة الإدارة والتعاون مع الجيران عملية بطيئة.
بعد انتهاء شهرَي الخدمة المؤقتة في الأبيض، انطلقت في سبتمبر إلى منطقتي الجديدة. في ذلك الوقت، كانت الوسيلة الوحيدة للسفر هي الحيوانات والسير على الأقدام. استغرقت الرحلة إلى رشاد عبر دِلينج وكادقلي وتلودي ودلامي أكثر من شهر، مسافة ٤٠٠ ميل. تعلمت في كسلا السفر بالجمال، أما الآن فكانت أول تجربة لي مع الخيول والبغال. سبتمبر شهر سيء للحركة جنوب خط العرض ١٢، حيث تتحول الكثبان الرملية إلى تربة طينية سوداء ومجاري مائية تعيق الحركة بعد المطر.
غادرنا الأبيض في صباح صافٍ، مجموعة من ١٢ فردًا: خادمان، فرسان، وشرطي مرافق. ركبنا أربعة خيول وثمانية بغال. كانت الأميال الثمانون الأولى سهلة؛ الريف متعرج، أخضر، وبدأ الذرة ينضج. بحلول منتصف النهار، توقفنا في بيت استراحة “سنجيكاي”، حيث التقيت بـ“هيو بوستيد” و“رسل سلمون” اللذين كانا في طريقهما إلى الأبيض. تسلقنا تلةً وشاهدنا الغروب، وتحدث بوستيد عن رحلته لقمة إيفرست. قضينا الليل هناك، وغادرا في الصباح.
بعد كادقلي، واجهنا أمطارًا مستمرة. الطريق مغطى بأعشاب عالية مليئة بالقراد، وتعرضنا لذبابٍ كثيف عذب البغال. عبرنا مجاري مائية عميقة بالوحل الأسود اللزج. في الليل، احتمينا في بيوت استراحة مليئة بالبعوض والعقارب. لكن في بعض المناطق، كانت التلال الجرانيتية مسالك صلبة، حيث نزل النوبة ليراقبونا ونعالج قروحهم بالصودا. حملت دائمًا مشرطًا وبرمنجنات البوتاسيوم لعلاج لدغات الأفاعي، واستخدمتها مرات عديدة.
وصلنا رشاد بعد ٣٢ يومًا، وأصبت بالملاريا. عولجت بحقنتين كينين، واهتم بي “روبن إيليس”. تعافيت سريعًا، وشهدت بعدها هجمات متكررة من الحمى، لكنني تجنبت الوقاية واعتمدت على الناموسية. لم يكن خلفائي محظوظين: كاد “جون روولي” يموت من الحمى السوداء، ونجا “ريجي دينجوول” من الحمى الصفراء في وباء خلال الحرب.
في تلودي، استقرّيت في منزل مساعد المفوّض، مبنى فخم كان سكنًا فيما ما مضى لحاكم جبال النوبة. كان يتكون من أربع غرف وتراسات، مع إطلالة على سهلٍ واسع. خلف المنزل، ارتفع جبل تلودي الضخم. جلبت أثاثًا بسيطًا من الخرطوم، وأضفت خزانة وكراسي من مزاد تاجر يوناني توفي بالحمى.
في المكتب، الذي يبعد ربع ميل عن المنزل، علقت سيوفًا وأعلامًا من حملة “لافوفا” العسكرية، مع بنادق ريمنجتون قديمة. أضفت ميداليات قدمها جندي نوبة عجوز، وعُلقت صور الملك جورج الخامس والملك فؤاد والسير ريجينالد وينجيت، الحاكم العام للسودان.
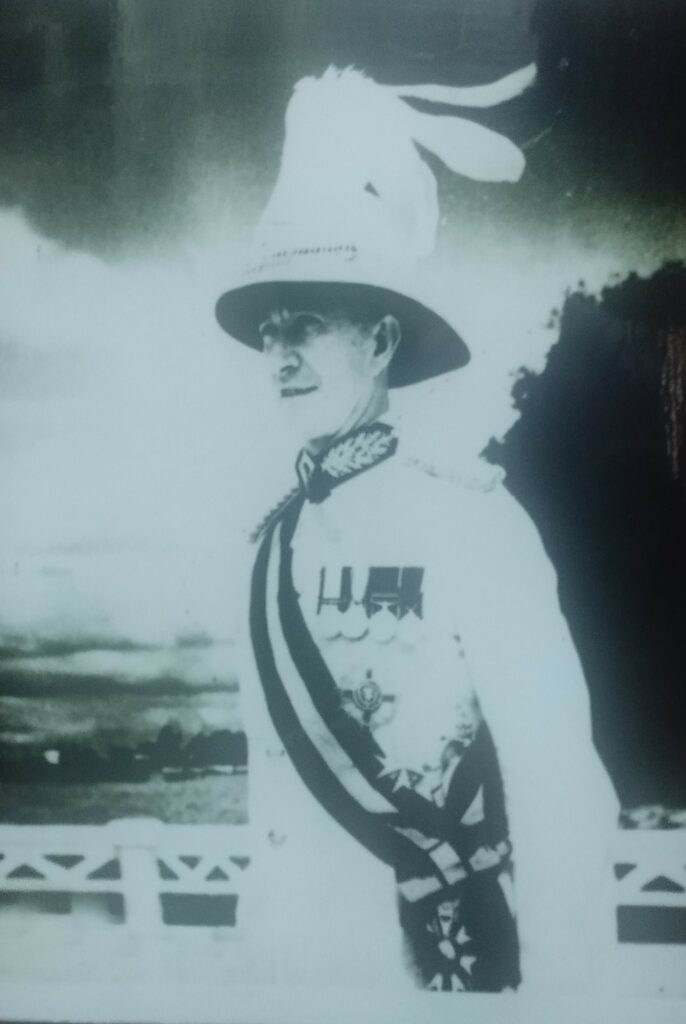
كانت جدران المكتب مُزينة بآثار دورية لافوفا التي حدثت قبل بضع سنوات. لقد كانت آخر حملة عسكرية ضد معقل جبلي للنوبة كان يحتله مجموعة صغيرة من أفراد القبائل المتمردة. كان هناك سيف زعيم المتمردين وعلمه، وبندقية ريمنجتون قديمة أو اثنتين، ورماح وسكاكين الرمي الخاصة بأتباعه. ولتجميل هذا العرض، أضفت لاحقًا مجموعة مذهلة من ميداليات الحملات التي أعطاني إياها جندي نوبي مسن متقاعد منذ زمن طويل للحفظ. بعد تركيبها وتأطيرها من قبل سبينك في لندن، أصبحت إضافة مهمة لهذه التذكارات الأخرى لحملة صغيرة ونائية جدًا. من وقت لآخر، كان مالك الميداليات الأشيب يزورني وينظر إليها بارتياح. أخيرًا، في أعلى الجدار المواجه لمكتبي، كانت هناك ثلاث صور كبيرة في إطارات داكنة ثقيلة. واحدة للملك جورج الخامس بلحية وبدلة بحرية. وأخرى للملك فؤاد مصر ، مع نهايات شواربه المثبتة بالشمع متجهة لأعلى بشراسة، مرتديًا بدلة مطرزة بوسام النيل على صدره وطربوش على رأسه. الثالثة للسير ريجينالد وينجيت الذي كان الحاكم العام من 1899 إلى 1916. كانت ميدالياته العديدة ونياشينه وأوسمته تغطي تقريبًا بدلته بالكامل. هو أيضًا كان لديه نهايات شواربه مثبتة بالشمع، لكن على عكس الملك فؤاد، كانت تبرز أفقياً. من بين الثلاثة، بدا الأكثر روعة، لكن عندما قابلته بالصدفة في لندن بعد عام أو نحو ذلك، بدا إنسانياً وودودًا تمامًا. هذه الشخصيات الثلاثة المهيبة حضرت بشكل رمزي وروحي خلال ساعات عملي.
في الطرف البعيد من الشرفة، حيث كان الزوار والمتقدمون بالالتماسات يتجمعون في انتظار دورهم لمقابلتي، كان يقع السجن وغرفة النظام للشرطة والخزانة ومكاتب الكتبة، وخلفها ساحة استعراض الشرطة، حيث كان هناك عمودان رخاميان بسيطان كل منهما يتوج بنسخة من الطربوش. لقد حددا الموقع حيث قبل سنوات عديدة، قام ضابط مصري، أفسدته حرارة تلودي ووحشتها، بإطلاق النار على زميله ثم وجه مسدسه نحو نفسه. في الطرف البعيد من ساحة الاستعراض كانت تقع مكتب البريد ونادي الموظفين وثكنات الشرطة؛ وعلى بعد ربع ميل تقع البلدة.
لم يكن لبلدة تلودي ما تتباهى به. كان هناك سوق مفتوح واسع محاط من ثلاثة جوانب بمحلات من طابق واحد ذات شرفات حيث كان النوبة يتجمعون لمشاهدة دهشة وهم يرون نصف دزينة من الخياطين العرب المحليين يدوسون على ماكينات الخياطة سنجر في الظل، يصنعون قمصانًا قطنية . كانت هذه المحلات توفر السكر والشاي والأقمشة المطبوعة والخرز وأطباق ملونة زاهية وغلايات معلقة على حبال من السقف. كان هناك تاجرين أو ثلاثة يونانيين ولبنانيين أو ثلاثة. باقي التجار كانوا عربًا من الشمال. لم يحققوا سوى عيش متواضع.
على الجانب الرابع من السوق، تحت ظل نصف دزينة من أشجار التين البرية الجميلة، كان يقف المستشفى الذي كان في وقت ما ثكنة عسكرية مصرية. بجانب السوق، قمت على مر السنين بإنشاء حديقة عامة بها شجيرات وأشجار ماهوجاني صغيرة محمية بأسوار شائكة من الماعز المتجولة، مع ممرات ومقاعد ومنصة فرقة اسمنتية مفتوحة. خلف المستشفى كانت تقع المنازل العشبية والمساكن التي يعيش فيها ثلاثة آلاف نسمة من سكان تالودي.
المشرف الإنجليزي الذي كان هنا قبل مجئ في تلودي، ماثيو وردزورث، كان فارسًا متحمسًا كان يقود عربة بخيول وأعاد إحياء الاهتمام المنقطع بلعبة البولو. حافظت على هذا التقليد، وخلال فترة وجودي كنا نلعب مرة أو مرتين أسبوعيًا خلال أشهر الشتاء، وأقمنا مباراة سنوية ضد كادقلي على بعد مائة ميل. تضمن لاعبونا المنتظمون المفتش الزراعي البريطاني، الضابط الشرطي السوداني وثلاثة أو أربعة من رجاله، كاتب السوق ومحاسب المكتب. كنا نلعب على أرض صلبة عارية كانت تُحفظ ملساء وخالية من الحفر والشقوق الخطيرة بواسطة مشذب بسيط يتكون من إطار حديدي ثقيل مثلثي مُلحق به أغصان شائكة مثقلة بالحجارة. كان يتم جر هذه الآلة بواسطة بغل. كان ملعب البولو يقع بجانب السوق وحضر مبارياتنا المسائية جمهور منتظم من المتفرجين الممتعين والمهتمين. السقوط أو الاصطدام المذهل أو هروب المهر كان ما يفضلون رؤيته، وغالبًا ما شاهدوا الثلاثة معًا.
كانت تلودي مكانًا منعزلاً ونائياً، لكن كقسم فرعي كانت وظيفة مثالية لشاب وخصوصًا لعازب، إذ وفرت قدرًا كبيرًا من الاستقلالية والفرص ليس فقط في المجال الإداري ولكن أيضًا في دراسة ثقافة النوبة. إن إثنولوجيا النوبة جذبت اهتمامًا نشطًا من عدد من مفوضي المقاطعات، كجزء من أعمال الإدارة، والمحاضرات في الأنثروبولوجيا التي حضرتها خلال عامنا الدراسي في أكسفورد أشعلت حماسي الخاص. لكننا كنا جميعًا هواة ولا شك أننا جميعًا استخلصنا استنتاجات خاطئة من بعض المعلومات التي جمعناها والملاحظات التي قمنا بها. رأى دوغلاس نيوبولد قيمة التقدير السليم للهيكل الاجتماعي للنوبة كمساعدة للمهام العملية للحكومة، وكان له دور في عام 1938 في تعيين الدكتور إس. إل. نادل لإجراء مسح كامل ومهني. كانت نتيجة أبحاثه نشر كتاب “تحقيق النوبة 1938-1941” بعد الحرب.
لمساعدتي في إدارة القسم الفرعي، كان لدي مأمور، يتعامل بشكل رئيسي مع الروتين اليومي ومشاكل المكتب، إلا عندما أكون في إجازة، فكان يتولى القيادة. ضابط شرطة سوداني كان مسؤولًا، تحت إشرافي العام، عن نحو ستين من رجال الشرطة المشاة والفرسان، جميعهم مجندون محليًا وأميون باستثناء ثلاثة أو أربعة.
في كسلا والخرطوم، تعلمت القواعد الأساسية لعمل مفوض المقاطعة. ما كان عليّ تعلمه – وهذا سيأتي فقط بالخبرة وارتكاب الأخطاء – هو كيفية تطبيق هذه القواعد بأفضل طريقة، وتعديلها إذا لزم الأمر لتناسب ظروفًا معينة. قبل كل شيء، كان عليّ أن أتعلم خطر التسرع. هذه الدروس وأشباهها جاءت إليّ جزئيًا من خلال الاتصال اليومي مع الناس الذين كنت أعمل بينهم، وجزئيًا من ستة رجال على وجه الخصوص حكمتهم وقلوبهم الطيبة سرعان ما تعلمت الإعجاب بها.
أحد هؤلاء، شريف عثمان، كان شرطيًا وصل إلى رتبة ضابط صف، وبعد تقاعده تم تعيينه كـ”وصي” على إليري، ليتولى الحكم حتى يبلغ الرئيس الشرعي، فتى في الرابعة عشرة، سن الرشد. كان سكان إليري أبناء وأحفاد العبيد الهاربين. كانوا مجموعة غير مسؤولة وفي نفس الوقت عدوانية، وكانت مهمة شريف صعبة. كان في الخمسين تقريبًا عندما التقيت به أول مرة: ضعف عمري. من أصل شمالي، كان بشرته فاتحة، طويل القامة ونحيل، بلحية خفيفة ووجه مجعد بعمق يعطي انطباعًا بقوة الإرادة والصبر. كان فارسًا ممتازًا، وحكيمًا ولبقًا كرفيق، ورجلًا شديد الولاء كرس السنوات السبع الأخيرة من حياته النشطة لخدمة الحكومة وشعب متعب.
خلال الفترة التي خدمت فيها في تلودي، قمت بزيارات عديدة لإليري وشريف عثمان، وقمنا بجولات عديدة معًا، عادةً على الخيل ولمدة يومين أو ثلاثة في كل مرة. كُنا نزور القرى وتعلمت الكثير منه. كان متحدثًا سهلًا، وكان لديه العديد من القصص عن أحداث عام 1924 عندما دعمت الفرقة المصرية في تلودي زملائهم المتمردين في الخرطوم، وعن الدور الذي لعبه في الحفاظ على استقرار الشرطة السودانية. مقابل هذا، تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية.
في عام 1938، عندما كنت خارج المقاطعة، فقد الرجل المسكين شريف عثمان عقله. كل النصائح الطبية والمساعدة لم تُجد نفعًا، وعندما زرته في الأبيض كان حطامًا مأساويًا للرجل الذي كان عليه. كان يُعتني به، بأفضل ما عرفوا، ولديه المخلصان، لكنه كان مربوطًا بسلاسل إلى عمود في غرفة داخلية مظلمة. أكثر الرجال لطفًا، أظهر علامات عنف وكان خوفهم الكبير أنه قد يرتكب شيئًا يجلب الإحراج أو العار للعائلة. لم يكن هناك مستشفى للأمراض العقلية في السودان والخيار البديل كان جناح المجانين في سجن الأبيض. لحسن الحظ بالنسبة له ولمن أُعجبوا به، مات بعد وقت قصير.
الثاني من الذين أدين لهم بالفضل كان محمد عبد الرازق، مأمور و ضابط إداري، المسؤول – كما كنت أنا أمام مفوض المقاطعة في رشاد. كانت منطقته تشمل مساحة من الريف كبيرة كإحدى مقاطعات إنجلترا، تضم خمسين ألفًا من الناس البدائيين والذين كانوا في أحيان كثيرة صعبة للغاية وعنيفة محتملة. جاء من دنقلا في شمال السودان وكان قد تلقى تعليمًا متوسطًا، وبعض سنوات الخدمة كمدرس ابتدائي ثم عامًا من التدريب كضابط إداري. لم يكن يعرف الإنجليزية. عندما التقيت به أول مرة، كان لديه بضع سنوات خدمة وخبرة أكثر مني، لكنه كان أقل مني رتبة بكثير. كانت معرفة محمد عبد الرازق وتأثيره على النوبة واسعين وعميقين، ولم يستطع أحد مقاومة ابتسامته المشرقة دائمًا ومرحه الذي لا ينضب. كان قصيرًا وسمينًا ويرتدي خوذة شمسية كبيرة تزيد من انطباعه الدائري الشبيه ببيكويك. ومع ذلك كان رجلًا ذا طاقة كبيرة، وماشيًا مفاجئًا في التلال، إذ كانت منطقته الفرعية مليئة بذبابة تسي تسي وبالتالي لم يكن قادرًا على استخدام الخيول أو البغال. على الرغم من أننا كنا نعيش على بعد أكثر من مائة ميل، كنا نرى بعضنا كثيرًا خلال الأربع سنوات التي خدمنا فيها.
كانت تلودي بلدة بسيطة: سوق مفتوح محاط بمحلات عربية، ومستشفى قديم كان ثكنة مصرية. أنشأت حديقة عامة بأشجار الماهوجني. أحيا الإنجليزي الذي سبقني في الخدمة هنا “ماثيو ووردزورث” لعبة البولو، وكنا نلعب أسبوعيًا مع مفتش زراعي وضابط شرطة سوداني.
كانت تلودي منعزلة، لكنها مناسبة لشاب أعزب يبحث عن الاستقلال ودراسة ثقافة النوبة. بدأنا نولي اهتمامًا لتنمية المنطقة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، خاصة بعد نجاح زراعة القطن. أنشأت الحكومة مراكز لشراء المحاصيل، ووزعت بذورًا محسنة. في التعليم، افتتحنا مدارس ابتدائية في المناطق الريفية.
كان أساس عملنا الحس السليم والمثالية، والتعاطف مع شعبٍ جمع بين المكر والصدق، والوقار مع روح الدعابة.
لم أره قط منزعجًا أو قلقًا على الرغم من المشاكل التي كان يسببها له الناس الذين يقعون تحت مسؤوليته، من رفضهم دفع الضرائب، والجرائم القتل المتكررة التي يرتكبونها، وغارات السرقة على ماشية جيرانهم. كان مسلمًا متشددًا، محافظًا في جوهره، ولا بد أن عري النوبة كان يزعجه.
كان واعيًا بشكل ملحوظ لللياقة والرتبة. ذات مرة خلال موسم الأمطار، دعاني لشاي الظهيرة في منزله بدلامي. كنت أقيم في بيت الاستراحة، فجاء لاصطحابي قبل الرابعة بقليل. كان المطر يهطل بغزارة، فأحضر معه مظلة خضراء كبيرة تكفي لحمياتنا معًا. بينما كنا نعبر ساحة استعراض الشرطة، برقت صاعقة تلتها فورًا قعقعة رعد مدوية. بمزاح كبير، سألته وسط ضجيج العاصفة إن كان يعتقد أن البرق يمكن أن يصيب الطرف المعدني لمظلة مثل التي معنا. تحولت ابتسامته الواسعة فجأة إلى جدية قاتلة. أجاب: “والله، إنه قادر على ذلك”. كم كنت حكيمًا ومحقًا لتنبيهه إلى الخطر الذي وضعنا فيه بلا مبالاة، وكيف يجب تجنب مثل هذا الخطر العبثي. وبيديه ممسكتين بمقبض المظلة، أدارها نصف دائرة ورمى بها بعيدًا. ارتطمت المظلة بالوحل وتزلزلت، بينما حملتها عاصفة رياح دارت بها مرارًا. رغم احتجاجاتي بأنني لم أعتقد جديًا أننا في خطر، واصلنا مسيرنا بلا حماية تحت المطر المنهمر. لاحقًا، استعاد خادمه المظلة وأغلقها في خزانة مع تعليمات بعدم استخدامها أثناء العواصف الرعدية مجددًا.
كان محمد عبد الرازق فارسًا ماهرًا، لكنه توقف عن لعب البولو بعد حادث. قال إنه سقط وتحطمت خوذته إلى مئة قطعة، وكان محظوظًا لنجاته بحياته، وكاد أطفاله يصبحون أيتامًا وزوجته أرملة. لم يكن لديه كبرياء زائف، وقد يبدو نهجه الحذر في الحياة وحرصه على إجلال الرتب العليا للبعض دلالة على نقص المبادرة وحتى الشخصية والشجاعة. لكنه أظهر الكثير من كليهما في تعامله مع النوبة. هو أيضًا، مثل شريف عثمان، كان صبورًا بلا حدود، ورغم اختلافه عن السيد جوروكس في كل شيء إلا الهيئة، شاركه اعتقاده بأن الإطراء يجذب الناس إلى الفضيلة أكثر من تخويفهم من الرذيلة. للأسف، مات هو أيضًا في سن مبكرة.
طوال ثلاثينيات القرن العشرين، رأى كبار الضباط البريطانيين في الخدمة السياسية أن ترقية السودانيين فوق رتبة مأمور خطأ.
كان الاعتقاد السائد أن مستقبل الإدارة يكمن في تطوير الحكم المحلي؛ تقليدي في الريف، وغربي الطراز في الحضر. سيصبح الضباط السودانيون مسؤولين تنفيذيين لمجالس القرى والمدن. جادلت الآراء بأنه لا يُنصف توقع ممارسة الضابط السوداني نفس السلطة التي يتمتع بها المفوضون البريطانيون – تمامًا كما لا يمكن لإنجليزي أن يكون مفوض مقاطعة في ساسكس. يبدو أن أحدًا لم يدرس النظام الفرنسي للإدارة المحلية تحت إشراف “البريفيه” وعمدة البلدة. لسوء الحظ، بعد أقل من عشرين عامًا، اضطرت الإدارة إلى تسليم الأمور بالكامل للسودانيين. حينها، كان عدد القادة المدربين أقل من المطلوب بكثير. بحلول 1939، اعتُبر محمد عبد الرازق وآخرون مؤهلين لأداء مهامي التي كنت أقوم بها عام 1933. رغم بطء الحكومة في الخرطوم بإدراك حتمية “سودنة” الخدمة المدنية، إلا أنها سبقت غيرها في تبني هذه الرؤية.
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، تلقى المأمورون تدريبًا جيدًا في مدرسة إدارة بأم درمان. وبفضل إجازات المفوضين البريطانيين المتكررة، اكتسب المأمورون خبرات قيادية أثناء غياب رؤسائهم.
أخيرًا، من بين من ساعدوني، الشيخ راضي كمبال، زعيم عرب أولا د حميد، قبيلة عربية صغيرة ترعى عند حواف جبال النوبة الشرقية. كان راضي محافظًا نبيلًا، لطيفًا يحظى باحترام كبير. بسبب إصابته بتضخم غدة درقية، كان يلف طرف عمامته حول حلقه، تاركًا شاربيه الرماديين وعينيه الثاقبتين ظاهرتين. راقب مجيء وذهاب المفوضين الشباب لسنوات، وساعد في بناء جسور الثقة بين الإدارة الأجنبية وقبيلته – جسور بدأت تتهاوى مع صعود النزعات القومية. كان راضي مسلمًا متدينًا، وكنا نطلب من الخدم إخفاء زجاجات الويسكي عند مرافقته. مثّل أفضل سمات الإدارة القائمة على التقاليد واحترام السلطة.
الحفاظ على السلام، تطبيق العدالة، تطوير الحكم المحلي، تحسين الزراعة، توسيع الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية – كانت هذه مهامنا الرئيسية. اعتمدنا على تعاون الزعماء التقليديين، إذ لم تكن هناك موارد كافية أو دعم دولي كما هو الحال اليوم.
في العشرين سنة الأولى من القرن العشرين، مثّل النوبة مشكلة عسكرية إلى حد ما، وكان هَمُّ الإدارة الأساسي يتمثل في منع نشوب النزاعات بين النوبة أنفسهم، وبينهم وبين جيرانهم العرب في السهول. وبالنظر إلى خلفيتهم التاريخية، لم يكن من المستغرب أن لا يتوقع النوبة حدوث تغيير لمجرد تغيّر الحكومة.
حتى أوائل العشرينيات، كانت الإدارة في مناطق النوبة مباشرة في جوهرها، ولم يُولَ اهتمام كبير للسلطات التقليدية الموجودة آنذاك. كان معروفًا أن السلطة في معظم المجتمعات النوبية كانت تتركز في شخصين: المك، وهو زعيم دنيوي يعاونه مجلس من الشيوخ، والكجور، وهو زعيم ديني يتمتع بقدرات خارقة، من بينها التحكم في المطر والجراد. في تلك الفترة المبكرة من الحكم، أصبح من الضروري تحديد الأهمية النسبية لهذين الزعيمين التقليديين، كل في نطاق نفوذه وسلطته، وذلك للاستفادة منهما في الحفاظ على السلام ورعاية شؤون الناس.
وفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى تجميع الوحدات القبلية الصغيرة والضعيفة، إما عبر دمج مباشر حيثما كان ذلك مقبولًا على نطاق واسع، أو من خلال شكل أكثر مرونة من الاتحاد. وكانت البداية بتأسيس محاكم اتحادية، وتبعتها لاحقًا ترتيبات إدارية أكثر تقاربًا. وبحلول نهاية العشرينيات، لم تعد المشكلة العسكرية ذات أهمية تُذكر، وقد تحقق بعض التقدم في إنشاء المحاكم ووحدات الحكم المحلي. استغرق هذا التطور وقتًا، لأنه لم يكن ممكنًا إلا من خلال التوافق، وحين وصلتُ إلى جبال النوبة لأداء خدمتي، كان لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لإقناع القبائل الصغيرة بضرورة التعاون الوثيق والفعّال مع جيرانها إذا أرادت أن تؤدي دورًا مؤثرًا في إدارة شؤونها القضائية والإدارية.
كانت إحدى المهام الأساسية للإدارة، كما ذكرت، هي الحفاظ على السلم ومنع النزاعات القبلية، خاصة بين النوبة القاطنين في الجبال و(البقارة)، وهم العرب الرعاة الذين يعيشون في السهول. بعد الفوضى التي أعقبت نهاية الحكم التركي-المصري في السودان، حصل النوبة على عدد كبير من البنادق من طرازات متنوعة. في بقية أنحاء السودان، كانت حيازة الأسلحة النارية تخضع لرقابة صارمة عبر نظام الترخيص، لكن النوبة حظوا بامتياز خاص: سُمح لهم بحمل السلاح، وفعلوا ذلك بالفعل. يُقدَّر أن عدد البنادق في جبال النوبة بلغ حوالي 20,000 بندقية، أغلبها من طراز ريمينغتون، تعود إلى سلسلة من الهزائم الكارثية التي مُنيت بها القوات المصرية قبل خمسين عامًا. ونظرًا لصعوبة الحصول على الذخيرة، كان النوبة يصنعون بارودًا بدائيًا وفتائل للاشتعال، ويعيدون تعبئة الخراطيش النحاسية القديمة مرارًا وتكرارًا.
وجدت نفسي في بعض الأحيان مضطرًا إلى قيادة مجموعة صغيرة من الشرطة، برفقة زعماء القبائل وأتباعهم، لإلقاء القبض على رجال ارتكبوا جرائم وتحدوا سلطات المحاكم المحلية. كنا نتحرك ليلًا، نتسلّق الجبال في الظلام، نُحيط بالمنزل على حين غرة، ونأمل في القبض على الرجل بهدوء. وغالبًا ما نجح ذلك. لكن في إحدى المرات في جبال مورو، أبدى المطلوب مقاومة شديدة، وقبل أن نتمكن من اقتياده بعيدًا، جاء أقاربه وأصدقاؤه لنجدته. وجدنا أنفسنا محاصَرين، لكننا تمكنا من تقييده بالأصفاد. رفضنا تسليمه، وفي المقابل، رفضت القرية السماح لنا بالمغادرة. كان ذلك قبل الفجر. تفاوضنا لساعات دون أن يتراجع أي من الطرفين. كان لدى القرية أسلحة، وكذلك نحن. استدعينا زعماء القرى المجاورة. استمر النقاش حتى منتصف النهار. أصررتُ على ضرورة محاكمة الرجل، وتعهدتُ بألا يكون الحكم قاسيًا. وفي النهاية غلب العقل، وأخذنا الأسير معنا. قضى محكوميته البالغة ثلاثة أشهر، ثم عاد إلى قريته.
في مناسبة أخرى، عندما كان من الضروري إلقاء القبض على رجل مطلوب في الجبال، فرّ راكضًا، وكان عاريًا تمامًا، يشبه في هيئته رياضيًا يونانيًا في لوحة فخارية وهو يركض، طويل الساقين، رشيق الحركة. طاردناه، وكان شرطي جديد يتقدمنا. على المنحدرات كانت هناك عشرات من الأشخاص يركضون، بعضهم أصدقاء الهارب يأملون في رؤيته ينجو، وآخرون خرجوا لمجرد الاستمتاع بمطاردة مثيرة. كانت التلال تردد صدى الهتافات والصيحات الحماسية. كان في المشهد مسحة من المرح والبهجة، لكن أيضًا توترًا خفيًا كان من الممكن أن ينفجر في عنف مفاجئ. في النهاية أُلقي القبض عليه، وقضى فترة سجنه، لكني أميل إلى الاعتقاد أنه بعد أن جعل ممثلي زعيمه -الذي تحدّاه- وممثلي الحكومة يركضون ويتصببون عرقًا عدة أميال فوق الجبال، شعر بأن الأمر يستحق، ولا أشك أنه يروي القصة الآن لأحفاده مزهوًا ومبالغًا في التفاصيل.
كانت مسؤوليتنا أيضًا أن نحرص على أن المحاكم المحلية تعامل الشاكين والمذنبين بعدالة، وإذا تجاوزت القضايا سلطاتهم، كنا نحن من يتولى النظر فيها. وكان العمل في المحاكم، سواء كنا نجري تحقيقًا أوليًا لتحديد ما إذا كانت هناك قضية مبدئية ضد المتهم، أو نحاكم فعليًا، هو ما يتيح أكبر قدر من التواصل القريب والحميم مع السكان. فالأدلة التي كنا نستمع إليها — أي تفاصيل الحياة اليومية والظروف الحميمة التي قادت إلى الجريمة — كانت تكشف الكثير عن حياة هؤلاء الناس. كانت غالبية القضايا تُنظر أمام المحاكم التقليدية وفقًا للقانون والعرف القبلي، أو أمام هيئات القضاة المحليين في المدن، التي تطبّق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وبالتالي، لم تكن تصل إلى مفوض المقاطعة أو مساعده سوى القضايا الأكثر خطورة — كالقتل العمد أو محاولة القتل، أو الأذى الجسيم، أو السرقة وقطع الطريق (والأخيران كانا نادرين). في مثل هذه القضايا، كنا نجلس كرئيس لمحكمة كبرى أو صغرى، يعاوننا قاضيان سودانيان في إصدار الحكم وتحديد العقوبة. نادرًا ما كان المتهم في قضايا القتل والقتل الخطأ ينكر التهمة. كانت للمحكمة الكبرى سلطة إصدار حكم بالإعدام، لكن أحكامها وتوصياتها كانت تخضع دائمًا لموافقة الحاكم العام، بناءً على مشورة رئيس القضاء. وقد ترأست العديد من هذه المحاكم.
وجدتُ كتاب “القانون الجنائي في الهند” ل:ماينز- عونًا كبيرًا في عملي القانوني، لا سيما عند صياغة حيثيات الأحكام. فقد كانت قوانيننا تستند في الأساس إلى النظام الهندي. ولم يكن السودانيون بطبعهم شعبًا قاسيًا أو انتقاميًا، لكن الظروف كانت تدفعهم أحيانًا إلى العنف الشديد والمفاجئ. كانت معظم جرائم القتل تنجم عن علاقات غرامية أو خيانة زوجية، أو نزاعات على ملكية الأراضي الزراعية، أو بسبب إتلاف المحاصيل نتيجة اجتياح الحيوانات لها. وكان من السهل أن تتطور هذه النزاعات إلى معارك قبلية تسفر عن قتلى وجرحى. ففي كردفان، كما في معظم مناطق السودان، كان الصراع الأزلي بين الزُرّاع والرعاة قائمًا. فقط في أقصى الشمال، حيث لا تسمح قلة الأمطار بالزراعة، كانت الإبل ترعى بحرية. أما في سائر المناطق، فكانت الحيوانات تمثل تهديدًا دائمًا للمحاصيل، وتسبب في وقوع عدد كبير من جرائم العنف يفوق ما تسببه أي عوامل أخرى. سواء بتواطؤ الراعي أو بدونه، كانت الحيوانات تقتحم الحقول وتتلفها. فيردّ صاحب المحصول الغاضب بالاستيلاء على الحيوانات أو قتلها، فيظهر الراعي، وتنشب معركة يشارك فيها نحو عشرة أفراد من كلا الطرفين، لتسفر غالبًا عن جروح، وربما عن مقتل أحدهم.
عندما يكون المتهم أحد أفراد القبائل، كانت القوانين تنص في بعض الحالات على إمكانية دفع الدية. في هذه الحالات، تصدر المحكمة الحكم الذي كانت ستصدره لو لم يكن المتهم من أبناء القبائل، لكنها تضيف توصية بأنه إذا وافق أهل القتيل والمدان على دفع الدية، وتم دفعها بالفعل، فإن العقوبة تُخفَّف. الفكرة من هذا الترتيب التوفيقي أن لأسرة القتيل والدولة حقوقًا متساوية في حالات القتل: الدولة تفرض عقوبة السجن، والأسرة تنال الدية. وبهذا يُرضى الطرفان.
كان لكل زعيم عربي أو نوبي مسؤول عن منطقة قبلية، ووحدة إدارية، ومحكمة عدلية، فرقة صغيرة من الشرطة الريفية أو المراسيل. وكان الزعماء يعتزون بهذه المظاهر السلطوية، ويُلبسون رجالهم ويُجهزونهم بأفضل ما تسمح به مواردهم الضئيلة. كنا نساعدهم بإعطائهم معدات شرطة خرجت من الخدمة، كالأربطة والسُرُج والصنادل. ومن صندوق احتياطي صغير، زودتُ شرطة زعماء النوبة بعمائم مزركشة وتنانير ملونة. وكانوا يوفّرون بأنفسهم أسلحتهم النارية، التي كانت أكثر زينةً من كونها فتاكة. مرة واحدة كل عام، كنا نستدعيهم إلى تلودي لحضور دورة تدريبية قصيرة تشمل تدريبات عسكرية وأساسية في مهام الشرطة. وكانوا يؤدون خدمة عامة لا تُقدّر بثمن، مقابل تكلفة زهيدة.
كنا مسؤولين أيضًا عن تحصيل ودفع ضريبة سنوية بسيطة، كانت في جوهرها مزيجًا بدائيًا من ضريبة على الثروة والدخل. وبعد إجراء تقييم تقريبي لعدد الرجال القادرين على العمل، وعدد رؤوس الأبقار والماعز في القبيلة، وقيمة المحاصيل النقدية المتوقعة، يُترك للزعيم وشيوخه تقدير المبلغ المستحق على كل أسرة. وكان المتوسط يبلغ حوالي سبعة شلنات. وهنا برزت فائدة قطيع الخنازير الذي كنت أملكه، إذ كان النوبة يربّون الخنازير ويتناولونها في مواسم الأعياد. فكان الزعماء الذين يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد يُمنحون اثنين أو ثلاثة خنازير كمكافأة، فيستمتع رعاياهم بوليمة جماعية.
كما كنا مسؤولين عن صيانة الطرق، والجسور، ونُزل الراحة، والمستوصفات، والمدارس، إذ لم تكن هناك إدارة للأشغال العامة في المنطقة. لذا فرضنا قدرًا من العمل الجماعي الإلزامي، وكنا ملزمين كل عام بتوثيق تفاصيل هذا العمل في تقرير يُرفع من الحكومة إلى عصبة الأمم. وكانت إعادة فتح الطرق بعد موسم الأمطار هي المهمة الرئيسية التي يُفرض فيها هذا العمل. وكل قرية تقع قرب الطريق كانت تُكلّف بقطعة منه، حسب عدد الرجال القادرين على العمل فيها. وكان ترميم نُزل الراحة المصنوعة من الحشيش شكلًا آخر من أشكال العمل الجماعي. وكانت ميزانية المقاطعة تمنحنا مبلغًا صغيرًا لإصلاح الطرق وصيانة النُزل، لكنه لم يكن كافيًا لتوفير أجر يومي للعشرات من الرجال المطلوبين. لذلك، كنا نستخدمه لشراء ثيران أو ماعز تُذبح وتُطعم للرجال العاملين. أعتقد أن كل قروي كان يؤدي، في المتوسط، خمسة أو ستة أيام من العمل الجماعي في السنة، وكان يتلقى في المقابل وجبة مشبعة أو اثنتين، بالإضافة إلى طريق معبّد يمكن السير فيه بسيارة، ومستشفى قريب من قريته يستفيد منه حتمًا.
لم نواجه أي صعوبة في تشغيل نظام السُّخرة. كان شرطي واحد يمتطي جوادًا – وغالبًا ما يكون من السكان المحليين – مسؤولًا عن امتداد طوله نحو عشرين ميلًا، وكان هو والعمدة يعرفان كيف يحافظان على فعالية الفرق وسعادتها. لم يكن العمل خفيفًا بالطبع؛ فالعشب الطويل الكثيف كان لا بد من قطعه، والحفر العميقة كان يجب ملؤها وترميمها، وكان لا بد من حفر قنوات التصريف واستبدال الجسور الخشبية أو تدعيمها. ومع كل هذا، كان الأمر أقرب إلى مناسبة جماعية مبهجة.
كان هناك الكثير من الغناء، خاصة عندما كانت النساء يأتين في فترة بعد الظهر وهنّ يحملن على رؤوسهن جرارًا فخارية كبيرة مملوءة بالجِعة المحلية المزبدة. كان كل شيء وديًا للغاية، وأبويًا إلى حد بعيد، وبالطبع كان من السهل جدًا تحريف صورة ما يجري. لقد استندت قدرتنا على إدارة هذا النوع من الأمور إلى سلطة نابعة من السمعة أكثر منها من القوة. أظن أنه يمكن القول إنه في نهاية المطاف – ورغم أن النوبة كانوا مسلحين جيدًا – كانت المسألة ببساطة:
“مهما حدث، فنحن نملك رشاش الماكسيم، وهم لا يملكونه”.
لكن نسبة الضباط الإداريين في المحطات النائية – بريطانيين وسودانيين معًا – إلى السكان كانت تقارب ثلاثة أو أربعة لكل ربع مليون نسمة. وكان السودان، الذي بلغ عدد سكانه على الأرجح ثمانية ملايين، يمتلك قوة شرطة قوامها ستة آلاف فرد.
بالإضافة إلى مستشفانا في تلودي – الذي كان المستشفى الوحيد في الجبال الشرقية – كان هناك مستوصفات في نحو نصف دزينة من المواقع الأخرى في المديرية، لكن السودان كان بلدًا فقيرًا، وكانت الخدمات الطبية، كغيرها، محدودة بما يتوفر لدينا من ميزانية. أصاب التهاب السحايا الدماغي النخاعي جبال النوبة مرتين أثناء وجودي هناك، وفي شتاء 1934/1935، وفي العام التالي، كانت الخسائر في الأرواح فادحة، خصوصًا بين الشباب. بدأ المرض في الظهور مع الطقس البارد الجاف، وبمجرد أن بدأ في الانتشار، لم يكن بوسعنا سوى حث الناس على تجنب التزاحم وتشجيعهم على النوم في ملاجئ مفتوحة بدلًا من التكدس داخل الأكواخ. وعندما يكون الطقس باردًا، يصعب إقناعهم بذلك. قضيت أيامًا طويلة ومرهقة أتنقل من قرية إلى أخرى، أتحاور مع العمد والشيوخ وجموع الناس، محاولًا شرح كيفية انتقال المرض. لم يكن هناك ما يمكن فعله طبيًا بمجرد أن يصاب الشخص به. لم تكن هناك وقاية. وجاء الوباء إلينا من الغرب، من دارفور. وبعد أن حصد أرواحًا كثيرة على مدار شتاءين، توقف عن تهديدنا، لكنه تبع بعد عامين بحمى صفراء. وكان الجذام منتشرًا، وكنا ندير مستعمرتين لمرضى الجذام، لكن ذلك كان قبل أيام اكتشاف الدابسون، ولم يكن لدينا علاج نقدمه لهم.
كانت هناك مناطق كثيرة في الجبال لم يتم مسحها أو رسم خرائطها بدقة من قبل، وكان بالإمكان القيام بقدر معين من العمل المفيد أثناء التنقل سيرًا في التلال باستخدام البوصلة، ورسم الخرائط التخطيطية، وكتابة تقارير الطرق، وتسجيل أسماء المعالم. وكانت مصلحة المساحة تتحقق من هذه المعلومات وتدرجها لاحقًا في الخرائط الممتازة للمديريات، والتي كانت تقوم بتحديثها وإعادة إصدارها كل بضع سنوات. وكان شعورًا مرضيًا أن يسجّل المرء تفاصيل مناطق نائية لم تكن قد ظهرت من قبل على الخرائط، مهما كانت أهميتها ضئيلة نسبيًا.
ومع تحوّل الرياح الشمالية الباردة في ديسمبر ويناير إلى حرارة خانقة ولاهبة في أشهر الصيف، بدأت حرائق الأحراش. ليلاً كانت تظهر كوهج شرير في الأفق، وفي النهار كأعمدة من الدخان الداكن تذروها الزوابع الترابية التي تميز الطقس الحار. كانت تنبعث منها رائحة لاذعة حادة تبقى عالقة لأيام. وكانت الأرض التي اجتاحتها النار تشبه حقلاً محروقًا، تنتشر عليه جذوع الأشجار المتفحمة والملتهبة. وأثناء اشتداد الحرائق، كانت الصقور والحدآت والنُّسور تحلّق في السماء مترقبة الطيور الهاربة والأرانب والسحالي والجرذان. وغالبًا ما كان الصيادون يشعلون هذه الحرائق، وهم يترقبون، من الجهة المقابلة للرياح، هروب الغزلان وغيرها من الطرائد. وكان من الغريب أن نرى كيف أن نباتات الحشائش الخضراء الجديدة تنمو بعد بضعة أيام فقط من عبور الحريق، وكأنها تظهر بمعجزة من أرض محروقة يابسة. ولكن، ورغم أن الحرائق كانت تدر ربحًا على البعض، فإنها كثيرًا ما كانت تؤدي إلى فقدان أراضٍ رعوية ثمينة، وتسبب تآكل التربة لاحقًا.
ولهذا، كانت القوانين القبلية تفرض عقوبات على من يثبت تورطه في إشعالها.
لم يكن هناك وسيلة واحدة لضمان أن المهام الكثيرة التي نحاول إنجازها يتم تنفيذها فعلًا، سوى بالسفر المستمر؛ ليس فقط في الطقس الجاف حين تكون الحركة بالشاحنة على الطرق أو سيرًا على الأقدام في التلال أمرًا ميسورًا نسبيًا، بل أيضًا خلال موسم الأمطار. وكان السفر في موسم الأمطار عملًا شاقًا، لكن ما كان يخفف من صعوبته هو الجمال الذي يظهر بسرعة بعد أشهر من الجفاف والحر. كانت الغيوم تتراكم غالبًا في منتصف النهار، ويهطل المطر قبل حلول المساء. وعندما ينطلق المرء عند شروق الشمس، يكون الطقس باردًا ومنعشًا بعد أمطار اليوم السابق. وكانت البلاد تفوح منها رائحة النقاء والغسل. أحيانًا تظهر شلالات مؤقتة تنهمر على منحدرات الجرانيت؛ وأحيانًا كان الضباب الأبيض يلف قمم الجبال. لكنه سرعان ما يصبح الطقس خانقًا، وعند نحو الساعة التاسعة يتوقف المرء لتناول الإفطار. وكان الهدف هو الوصول إلى محطة التوقف قبل أن تهب عاصفة بعد الظهر. وعندما كانت العاصفة تضرب، كانت تضرب بعنف شديد. تمطر الجبال كأنها شلال رمادي، ويتردد الرعد ويدوي حول القمم. وإذا ما كان منزل الاستراحة ذو سقف جيد، يمكن للمرء أن يدخل سريره تحت الناموسية ويقرأ على ضوء مصباح ضغط الهواء.
أما إن كان السقف من القش ويعاني من التسرب، فكانت الليلة تصبح بائسة للناس، وللحيوانات، وللشخص نفسه. وكانت هناك أيام، إذا فاضت مجاري المياه، لا يمكن للمرء أن يبرح المكان الذي قضى فيه الليل.
وربما يعطينا هذا المقطع من رسالة كتبتها إلى والديّ في يونيو 1937 صورة عن طبيعة الحياة والمهام التي تقع على عاتق كل واحد منا في المحطات النائية، خصوصًا في موسم الأمطار:
“وصلتُ إلى رشاد ظهر الأمس بعد أن قضيت ليلة في معسكر للأولاد حُميد، حيث التقتنا شاحنة المديرية، وهناك تركنا خيولنا وبغالنا لتلحق بنا لاحقًا. في الساعتين الأخيرتين من الرحلة كنا نخوض ببطء وسط طين عميق.
كانت الأمطار تتساقط. كنت أقود الشاحنة، وإلى جانبي شيخ كنا نحضره إلى المستشفى، وكان يبدو ضعيفًا جدًا، وقد سقط ميتًا على كتفي قبل أن نصل إلى وجهتنا. في مؤخرة الشاحنة، إلى جانب العريف السائق، كان هناك الطباخ، وخادمه، وخادمي الشخصي، وجندي من قوة الجمال عائد من إجازة، وطالبان، وزوجة الشيخ، وزوجة شرطي، وشرطي قبلي، ومجنون مكبل بالأصفاد يبكي ويضرب رأسه بأرضية الشاحنة. وفي أثناء توقفنا، أفلت من قيوده وهرب إلى الحشائش العالية الكثيفة. بحثنا عنه، لكننا لم نجده”.
لكن المشي في التلال في موسم الجفاف كان مهمة ألطف وأكثر جدوى. فالقُرى الواقعة في أعالي الجبال كانت تسكنها عادةً أكثر الناس خجلًا وبدائية في المديرية، أناس نادرًا ما كان آباؤهم، بل وأجدادهم بالتأكيد، يغامرون بالنزول إلى السهول خوفًا من غزوات الفرسان. وكانت بيوتهم الحجرية الجميلة ذات الأسقف المصنوعة من القش تتجمع مثل أعشاش السنونو على حواف التلال، أو تنتظم حول بئر أو مجرى مائي جبلي. وكانت ثلاث أو أربع أكواخ تُبنى متلاصقة في دائرة، مشكلةً فناءً صغيرًا يُدخَل عبر مدخل منخفض وحيد. وكان كل مسكن يمثل ما يشبه القلعة المصغرة التي يمكن غلقها والدفاع عنها عند الحاجة. لكل كوخ غرضه الخاص؛ واحد للنوم، وآخر للطبخ، وثالث لتخزين الحبوب، ورابع للخنازير والماعز. الجدران من الداخل كانت مكسوة بالطين، أما من الخارج فكانت مزيّنة برسوم هندسية ملوّنة بالأبيض والأسود واللون المغرِي. وكان الحطب مرصوصًا بدقة بمحاذاة الجدران الخارجية، وداخل الفناء كانت الجرار وأدوات الزراعة في أماكنها، وفي حجرة النوم كانت الرماح والسكاكين وربما بندقية جاهزة للاستخدام. كل شيء كان في موضعه، وكانت البيوت تُكنس باستمرار.
كان التنقل على الأقدام عبر مسارات ضيقة متعرجة ووعرة يتطلب وجود حمّالين لحمل الفراش، وصندوق الطباخ، وطاولة قابلة للطي، وكرسي التخييم وما شابه. وكان من المعتاد أن تتطوع الفتيات والنساء الشابات، المعتادات على حمل سلال الحبوب من السهول، بهذا العمل.
وكان الرجال، من دون خجل، يقولون ضاحكين إن الأمر مرهق جدًا بالنسبة لهم. وعلى المنحدرات الصخرية، كانت القافلة من السود تصعد في خط واحد، كل فتاة تحمل حمولة فوق رأسها، منتصبة القامة، وتحمل عصًا طويلة لحفظ التوازن. وكانت الزيوت على أجسادهن تفوح منها رائحة غريبة، ليست كريهة، بل نفّاذة وعالقة. وكنّ يتحدثن كالعصافير وهنّ يتنقلن بين الصخور. كنا ندفع لهنّ حسب المدة التي استغرقها الصعود، ساعتين أو ثلاث، وعادةً ما أضيف إلى الأجر حفنة من الخرز الملوّن أو الملح. ومرةً أخرى، كان كل شيء أبويًا للغاية، نعم، لكنه كان ودودًا ومبهجًا. من العبث أن نُدين مثل هذه الممارسات والعلاقات التي خلت من الكراهية أو الغِلّ أو القسر أو الخوف. ومن العبث الادعاء بأنها كانت شكلًا من أشكال القهر أو أن فيها ما يجرح الكرامة.
لم يشعر النوبة بأي خجل من أعضائهم التناسلية، إلا ربما عند زيارتهم لمدينة تلودي، حيث كان احترام غامض لهذا الهامش من “التحضّر”، وربما الخوف من النقد العربي، يدفع الرجال — أكثر من النساء — إلى القيام ببعض المحاولات لتغطية أنفسهم. كانت الفتيات غير المتزوجات يمشين عاريات تمامًا عادة، باستثناء خيط من الخرز حول أعناقهن. أما النساء الأكبر سنًا فكنّ يرتدين أوراقًا أو أربطة جلدية حول الخصر. ومع ذلك، كنّ جميعًا يزيّن أنفسهن بطرق متنوعة. وكانت الفتيات على وجه الخصوص يخضعن لعملية مؤلمة من “التندب الجمالي” رسم لعلامات وندوب خلال أول حمل لهن، تُرسم خلالها أنماط معقدة من الندوب على الصدر والبطن والظهر. كما كنّ يثقبن شفاههن السفلى ويضعن فيها أسطوانات حجرية طويلة، وأحيانًا رصاصة بندقية من نوع 303. وحواف آذانهن كانت تحمل عشرات الحلقات النحاسية. وعند البلوغ، كان كل من الأولاد والبنات يُنتزع منهم السن الأوسط في الفك السفلي باستخدام رأس رمح. وكان الشبان يثقبون أنوفهم ويزينونها بريش النيص أو بأسنان الجرذان، كما كان كثير منهم يضفرون شعرهم ويغطونه بالجبن الأبيض في تصاميم معقدة تشبه نجم البحر أو غيرها. وكانوا يزيّنون أجسادهم بالزيت والرماد والحناء الحمراء. لم تكن الختانة معروفة من قبل، ولكنها بدأت تنتشر بين البعض، وخصوصًا من خدموا في الجيش أو الشرطة.
صادفت ذات مرة مجموعة من ثلاثة شبان قاموا بختان بعضهم البعض قبل يومين باستخدام فأس خفيف كان يحملونه عادة، بعد أن شحذوه واستخدموا صخرة كلوح تقطيع. كانوا في حالٍ سيئة، ولحسن الحظ تمكنت من إيصالهم إلى المستشفى تلك الليلة.
في بعض التلال، كان الختان امتيازًا يُمنح لكبار السن من الرجال ذوي المكانة العالية. وبمجرد إجراء العملية، كان يُسمح لهؤلاء الشيوخ بحمل التبغ في كيس مصنوع من جلد القطط. ولحسن الحظ، فإن ختان الإناث — الشائع في شمال السودان المسلم — كان نادرًا في جبال النوبة.
في شمال السودان، كانت الحشمة الإسلامية تعني أن المرء يُترك وشأنه حتى عند تبديل ملابسه أو استحمامه في وسط القرية أو المعسكر. أما في جنوب السودان، فلم تكن هناك مثل هذه القيود. ففي جبال النوبة، كان أكثر من عشرة وجوه صامتة ولكن شديدة الاهتمام تتزاحم تحت سقف النزل العشبي بينما أجلس في حوض استحمام قماشي صغير تحت ضوء فانوس زيت. وعندما أخرج لأجفف نفسي، كانوا يبدون اهتمامهم بهمس طويل من التسلية.
غالبًا ما كنت أزور قرية، أُنجز ما يلزم من مناقشة قضايا قانونية، أو جمع ضرائب، أو الحديث عن المحاصيل أو مصادر المياه، ثم يحل وقت فراغ في فترة بعد الظهر أو المساء. كنت أتجول بين المنازل أو أتسلق تلاً قريبًا وأتحدث مع من ألتقيهم. في إحدى تلك الأمسيات، جلست وحدي على تلّ بالقرب من مركز الشرطة في “هيبان”، على بعد سبعين أو ثمانين ميلًا شمال تلودي. كان في الموقع سجن صغير، ومفرزة شرطة من ستة رجال بقيادة عريف، ونُزُل ومكتب أعتمد عليه أثناء الزيارات التفتيشية. وبينما أجلس أتأمل المشهد، أقبل نحوي شيخ. بابتسامة ودودة حيّاني بالعربية، وجلس بجانبي. لم يكن يرتدي سوى عقد حول عنقه. كنت أدخّن غليوني، فأخرج هو غليونه من حقيبة جلدية صغيرة مربوطة بمعصمه. كان له رأس فخاري وساق خشبية مزينة بأسلاك نحاسية. نظف الغليون، ثم نظر إليّ. تنهد وألقى نظرة بعيدة نحو الأفق. فهمت الإشارة وأعطيته كيس التبغ. أشعل غليونه، وملأ كيسه الخاص، واستمتع بنكهة تبغ “بلايرز نيفي كَت”، وابتسم امتنانًا. قال لي إنه جندي سابق خدم في الكتيبة العاشرة السودانية بالجيش المصري، وكان في قناة السويس خلال حرب 1914–1918. “آه، كانت أيامًا عظيمة.” قال إنه كان في الفرقة الموسيقية. ثم، بخجل وهدوء، بدأ يغني. لم أفهم اللحن أو الكلمات في البداية، ثم فجأة عرفتهما: كانت أغنية “I Love a Lassie” التي تعلمتها الفرقة عام 1916. كان هاري لودر سيسر بذلك.
يا لها من بقايا غريبة تركتها الحضارة الإمبريالية لهذا الرجل العجوز.
كانت الحياة اليومية تتبع نمطًا ثابتًا رغم تغيّر البيئة والظروف. كان محمد، كبير الخدم، يوقظني قبل الفجر بقليل ويجلب لي كوب شاي. السماء صافية، والهواء بارد وساكن، والشمس لم تشرق بعد. تنتشر رائحة العشب الجاف واسطبلات الخيل المجاورة. بحلول السادسة والنصف، أكون قد ارتديت ملابسي، ويكون عليّ وحسن، الخادمان، ومعهم ثلاثة جياد، بانتظاري أسفل الشرفة. كنت أحتفظ ببعض التمر المجفف في جيبي لأكافئ الخيول به بعد الجولة. كنا نهبط التل الذي تحفّه أشجار القطن التي زُرعت قبل 10 أو 15 سنة، والتي أصبحت الآن بطول ثلاثين قدمًا. كنّا جميعًا نزرع الأشجار، وإذا سُقيت وحُميت من الماعز بالأشواك، فإنها غالبًا ما تزدهر.
غالبًا ما كنت أمر بالمكتب وأدخل المدينة. مرة في الأسبوع كنت أشاهد عرضًا للشرطة، ومرة أخرى أقوم بجولة تفتيشية في المدينة.
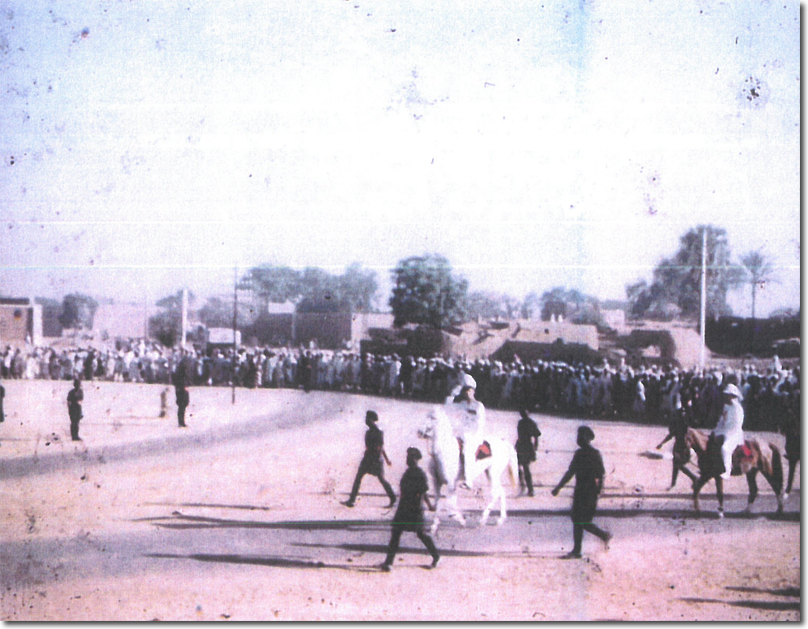
أحيانًا أزور المزرعة التجريبية التابعة لقسم الزراعة أو المستشفى للحديث مع الدكتور عكاشة أو لزيارة المرضى، أو أتفقد الحديقة التابعة للمنطقة، حيث يعمل بعض السجناء “حسن السيرة” في زراعة الخضروات. كانت الليمون والموز والجوافة والباباي تنمو جيدًا، وتُوزّع يوميًا على موظفي المكتب.
في الثامنة أعود للمنزل، وبعد استحمام سريع ووجبة فطور تتكون من فواكه وبيض وشاي، أذهب إلى المكتب حتى حوالي الثانية والنصف، حيث أتناول الغداء: حساء بارد، لحم بارد، وسلطة، تليها قهوة تركية حلوة. كان البيت مظللًا ضد الحرارة، وفي ضوء خافت كنت غالبًا أقرأ حتى الرابعة والنصف، ثم أخرج للمشي أو ركوب الخيل حتى الغروب. بعد ذلك استحمام آخر. جربت النوم القيلولة، لكني وجدت أني أستيقظ بكسل شديد، لذا تجنبتها إلا في حال كنت مرهقًا. كنت أنجز عملي المسائي بين السابعة والثامنة والنصف تقريبًا، وربما أُعدّ قضية جنائية، أو أكتب ملاحظات قبلية، أو أُعدّ تقريرًا. وكان من الأسهل إنجاز الأعمال غير الروتينية بعد ساعات الدوام، لأن المكتب خلال النهار كان مليئًا بالزوار.
من حين لآخر، كنت أدعو موظفي المكتب أو بعض التجار الكبار لشاي العصر. وأحيانًا أستضيف ضيفًا لليلة أو اثنتين، أو يأتي أحدهم من زوار تلودي لتناول العشاء، مصطحبًا معه مصباحًا كهربائيًا — وعصا، تحسّبًا للثعابين. لكن في ست ليالٍ من كل أسبوع، كنت وحدي. هكذا كانت الحياة في تلودي.
أما في الجولات، والتي كنت أقوم بها لأكثر من نصف الشهر، فلم تتغير مواعيد الاستيقاظ أو الطعام أو النوم كثيرًا، لكن لم تكن هناك ساعات عمل محددة، وكنت أتنقل من قرية لأخرى حسب الحاجة. في المساء، نادرًا ما كنت وحيدًا، إذ كان شيوخ القرية يجتمعون حول ناري، خصوصًا في الشتاء أو مواسم الأمطار في القرى الجبلية، يشربون شايًا حلوًا بالحليب المكثف ويتحدثون.
وغالبًا ما كنت أعود من الجولات ومعي اثنان أو ثلاثة مرضى يحتاجون علاجًا في المستشفى. كان “دوالي الخصية” من الأمراض الشائعة بين الرجال الأكبر سنًا، وتتجلى في تضخم خصية غريب الشكل. وكانت العملية الجراحية بسيطة نسبيًا، وغالبًا ما كان المرضى المتعافون يراقبونها بدهشة من نافذة غرفة العمليات، حيث يشاهدون الدكتور عكاشة ومعاونه الأعور “الجاك” يقومان بعملهما الغامض المثير. وكان الشفاء سريعًا، والعودة إلى الحالة الطبيعية مصدر فرح للمريض وعائلته، الذين كثيرًا ما كانوا يرافقونه إلى تلودي سيرًا على الأقدام. وكمبادرة علاقات عامة، كانت هذه العملية تسهم كثيرًا في تعزيز صورة الحكومة.
في أوائل الثلاثينيات، بدأ تركيزنا يزداد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جبال النوبة. كانت زراعة القطن المطري كمحصول نقدي قد أُدخلت قبل سنوات، وحققت رواجًا، وانتشرت زراعته بسرعة. أنشئت مراكز شراء حكومية خلال موسم الحصاد، حيث تُجمع المحاصيل، وتُصنف وتُوزن وتُشترى. في تلودي، كان “جون كولمان”، مفتش الزراعة، ومساعده السوداني يديران مزرعة تجريبية لاختبار أنواع محسّنة من القطن والمحاصيل الغذائية، وتُوزع البذور منها. أما في مجال التعليم، فقد بدأنا نستجيب لطلب متزايد ببطء. كانت المدارس الأولية قائمة بالفعل في مراكز الحكومة الرئيسية، وتدعمها مدارس ابتدائية في المناطق الريفية ومراكز القبائل.
وقد يتساءل المرء: ما الذي كان يقف وراء الأسلوب الذي مارَسْنا به تلك الصلاحيات والمسؤوليات الواسعة؟ أظن أنه أولًا الفطرة السليمة، وثانيًا قدر من المثالية، مقرون بدفء شعوري قلّ أن يتجنبه من عاش عن قرب مع هؤلاء الناس.
أناس جمعوا بين الدهاء والاستقامة، والقدرة على السخرية والكرامة، والصراحة والبساطة مع لياقة فطرية؛ مزيج فريد تجلى في ملامحهم العميقة التجاعيد والابتسامة الخفيفة الماكرة.
كان النوبة يحبّون التبغ بشدة. كانوا يزرعونه ويدخنونه ويمضغونه. وكان يُستخدم في بعض المناطق كمكوّن من مكونات مهر العروس، على شكل أقراص كبيرة تشبه الكعك، تقدم لوالدة العروس. وكان يُدخّن في غلايين حجرية أو فخارية من قبل كبار السن من الرجال والنساء. وكانوا أيضًا يمضغونه مع قطعة من الملح الصخري، ويحتفظون بهذه الكتلة في أفواههم لساعات، مما يُنتج الكثير من اللعاب البني، فأصبحوا خبراء في البصق الدقيق والبعيد. وكان الشباب والمتزوجون حديثًا يتجنبونه، ويقولون ضاحكين — وبحكمة — إنه يُفسد رائحة النفس، وإن رائحته تُنفرهم. وكانت الغلايين من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها للزعماء والشيوخ، وكنت أشتري منها اثنتين أو ثلاث عشرات أثناء إجازتي السنوية من محلات “وولوورث”، بسعر 6 بنسات لكل واحدة. كما كنت أجلب أمشاطًا ملونة، يعلقها الشيوخ حول أعناقهم، وعندما لا يكون لديهم ما يفعلونه، يمشّطون لحاهم الرقيقة القليلة الشعر. لم يكن النوبة شعبًا كثيف الشعر.
كانوا يستمتعون ويبرعون في مجموعة من الألعاب الرجولية: المصارعة، رمي الرماح الخشبية على بعضهم، القتال بالعصي والدروع، سباقات الضاحية، والقتال بأساور معدنية على المعصمين في كاو، ونيارو، وفنغور. كانت الأخيرة لعبة خطيرة رغم وجود قواعد صارمة وحكام، وقد رأيت رجلاً يقتل خصمه خلالها. نشرت صحيفة بريطانية مؤخرًا صورًا رائعة لهؤلاء الناس، ووصفتهم بأنهم قبيلة لا يعرف بوجودها إلا حفنة من علماء الأنثروبولوجيا. لكن هؤلاء الناس من كاو، ونيارو، وفنغور كانوا ضمن نطاق منطقتي، وكنت أزور تلالهم كثيرًا، كما فعل غيري من المسؤولين. وزعمت المقالة أيضًا أن هؤلاء لا يؤمنون بوجود قبائل نوبة أخرى — وهو أمر غريب، لأن شبابهم كانوا يحضرون كل عام إلى تلودي لحضور مهرجان زراعي يستمر يومين، وكان الهدف منه توحيد النوبة. والأغرب أن المقالة ادعت أن طلاء أجساد ووجوه هؤلاء الناس كان يُعتبر بدائيًا و”مقرفًا” من قبل الحكومة الاستعمارية البريطانية، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.


اترك تعليقاً