” فشودة ربما تكون مختلفةً عما أتذكره في أيام ميج نيادوك واد يور، كنتُ أتمنى أن أرى بلدي مرةً أخرى. لكنني- كما أنا، سأخدم الحكومة ما دام حصاني يحملني، وإذا عشت حتى أرى السرية الثانية من الكتيبة الثانية عشرة السودانية تتصرف كما آمل وأعرف أنها ستفعل حين يأتي اليوم العظيم في أم درمان، فحينها سأكون مستعدًا للمغادرة، وعلي جيفون ربما لم يعش عبثًا.”…
– علي جيفون، “مذكرات جندي سوداني”، مجلة كورنهيل، أكتوبر ١٨٩٦م
كان علي جيفون عائدًا إلى وطنه. بعد أربعين عامًا تقريبًا من آخر مرة رأى فيها “فوت شول” (أرض الشلك)، كان يراقب حصن الفشودة يظهر ببطء في الأفق، بينما يتدفق النيل شمالًا نحو الخرطوم ومصر. أُسِرَ شابًا على يد تجار الرقيق البقارة، وانضم إلى الجيش المصري، وخاض علي جيفون معارك لا تحصى على مر السنين في شمال شرق أفريقيا، وحتى في المكسيك ذات مرة. والآن ها هو في صباح ١٩ سبتمبر ١٨٩٨، هذا الجندي الشلكي العائد إلى مسقط رأسه، ليس مُقيدًا كعبد، بل كمساعد آمر في جيشٍ منتصر. بل إنه بصفته ” Lord Salisbury” (رتبة عسكرية سودانية)، كان أعلى رتبةً بين الجنود السودانيين في الجيش المصري بأكمله آنذاك.
كانت المفارقة الغرائبية أنه هو وزملاؤه الجنود السودانيين كانوا يبحرون عكس تيار النيل لاستعادة فشودة ، في الماضي أبحرو مع تيار النهر كمستعبدين، اليوم وبإسم عباس الثاني خديوي مصر، الذي كانت ضرائب عمه الأكبر السبب غير المباشر لتجنيدهم قبل أربعة عقود. بالطبع، كان للفرنسي جان-باتيست مارشاند رأيٌ في المطالبات الإنجليزية-المصرية بالمنطقة ذلك اليوم من سبتمبر، لكن هذه قصة – أو “حادثة” – مذكورة بتفصيل في الكتب التاريخية. أما قصة عودة علي جيفون إلى الفشودة، وبشكل أوسع، قصة كل الجنود السودانيين الذين حاربوا في “حرب النيل”، فقد طواها النسيان، كرواية نيلية لم تُحكَ قط.
حرب النيل مجددًا: الجنود السودانيون و”استعلاء الأجيال اللاحقة”
رغم أن “سقوط الدراويش” دُوِّن مراتٍ عديدة منذ أن استعاد كتشنر الخرطوم السودان في نهاية القرن التاسع عشر – من كتاب ونستون تشرشل الكلاسيكي “حرب النيل” (١٨٩٩) إلى حساب دومينيك جرين الأحدث “ثلاث إمبراطوريات على النيل” (٢٠٠٧) – نجد أنه نادرًا ما كُتب عن الأفارقة الذين شاركوا في هذه الحملة. بتجاهلهم أو تحريفهم لدور الجنود السودانيين والمصريين، أعاد المؤرخون الإمبراطوريون والعسكريون سرد معركة أم درمان مرارًا – مثلًا – بالحديث بتفصيل عن “هجوم الفرسان الحادي والعشرين” المشؤوم، أو بالتركيز على المعركة بوصفها “أعظم انتصار حققته أسلحة العلم على البرابرة”. وهكذا، يخرج المرء بانطباع خاطئ بأن حرب النيل كُسبت بفضل الفيالق البريطانية ومدفع المكسيم، وليس بواسطة كتائب المشاة السودانية – التي شكلت، مع القوات المصرية، ثلثي الجيش الإنجليزي-المصري في أم درمان، وكانت أهميتها الاستراتيجية والتكتيكية للحملة تفوق بأشواط تلك الخاصة بالقوات البريطانية.
تتميز سرديات حرب النيل بأن الكثير مما وثقه شهود العيان تم تجاهله أو إهماله من قبل المؤرخين اللاحقين. ما لم يقرر المرء العودة إلى المخطوطات الأرشيفية أو إزالة الغبار عن كتب الحملات القديمة المنشورة في تسعينيات القرن التاسع عشر، فسيبدو أن حملة النيل خُضِعت أساسًا (الجنود البريطانيين) بقبعات القش؛ وأن النساء لم يلعبن أي دور في هذه الأحداث؛ وأن الجنود السودانيين كانوا عديمي المهارة والانضباط، وبالتالي غير موثوق بهم في القتال؛ وأنه لم تكن هناك أي مودة عرقية بين الجنود السودانيين وإخوانهم البريطانيين، ولا أي تواصل بينهم وبين قوات المهدية أو المدنيين. في الواقع، يظهر الجنود السودانيون كمجرد آلات عسكرية مرقمة – بلا أسماء أو وجوه أو رتب، مجرد بيادق إمبراطورية، مُستَوعَبَة ربما، أو مضطهدة ومستغَلة، لكنها شخصيات هامشية بلا هوية أو إرادة، بلا ثقافة أو تاريخ. مثل هذه التصويرات (أو غيابها) تعطي انطباعًا بأن الجنود السودانيين كانوا رموزًا لاتاريخية، وبلا صلة بـ”المسألة المصرية” أو التدافع العام على أفريقيا.
علاوة على ذلك، حتى لو فتش المرء في الأرشيفات أو أعاد قراءة المصادر المعاصرة المهملة، فسيظهر أخطاء وحذوفات جديدة – غالبًا ما تُكرر – ناتجة عن السياق التاريخي وجهل الوقائع: كالاعتقاد أن كتائب المشاة السودانية، التي تشكلت خلال إعادة تنظيم الجيش المصري في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانت ظاهرة جديدة؛ وفكرة أن هذه الوحدات تألفت من “متطوعين” جدد بدلًا من جنود عبيد مخضرمين؛ والوهم بأن هؤلاء المجندين “الخام” لم يصبحوا جنودًا “مكتملين” إلا بفضل قدرات القيادة الفريدة للضباط البريطانيين؛ وأخيرًا، الافتراض الشائع أن الجنود السودانيين كانوا مجموعة متجانسة عرقيًّا وجغرافيًّا، مؤلفة حصرًا تقريبًا من “أعراق محاربة” من أعالي النيل، وخاصة الشلك والدينكا.
استنتاج
الأمر الأهم في هذا التنقيب التأريخي هو أن كتاب “عبيد الحظ“ يهدف إلى إظهار أن الجنود السودانيين لم يكونوا مجرد دمى إمبريالية، ولا رموزًا لاتاريخية. فعلى الرغم من تعرضهم للعنف، والقطيعة عن الأصول، وأشكال أخرى من “العار المُعمم” – وفق نموذج العبودية الذي قدمه أورلاندو باترسون – فإن هؤلاء الرجال تحملوا، وتجاوزوا – فعليًّا – “موتهم الاجتماعي” من خلال صنع حياة ذات معنى من ما قدَّمه لهم القدر. بل إنهم كانوا أكثر من مجرد أدوات إمبريالية بلا هوية أو سلطة، أو “أعراق حربية” مسخَّرة للإمبراطورية، وبلا تأثير على التاريخ الأفريقي أو الأوروبي.
بل كانوا فاعلين تاريخيين من لحم ودم، ذوي ولاءات وهويات معقدة، سواء كأفراد أو كـ”جنود سودانيين” بشكل أوسع. وفي تلك الكتائب الست السودانية التي حاربت في حرب النيل – المُسجلة دائمًا بأرقام رومانية باردة من IX إلى XIV – كانت هناك آلاف السير الذاتية الفريدة، كل حياةٍ مُميزةٍ بحبها وولاءاتها، وصداقاتها وخصوماتها، ومشاعرها المتناقضة وهشاشتها البشرية، التي تجلت أحيانًا في أفعال حقد وتسوية حسابات، وتجلت أحيانًا أخرى في أفعال لطفٍ وطيبةٍ بشريةٍ استثنائية.
خلافًا للحكمة التقليدية، فإن هؤلاء الرجال – كجنود في جيش الخديوي – امتلكوا إحساسًا بالقوة الجماعية والفخر الحربي، وما صاحب ذلك من قدرة على الفعل. فقد تمرد الجنود السودانيون أحيانًا، ولم يترددوا في نقل ولائهم لراعٍ آخر إذا اقتضت الظروف. مرة أخرى، أدى “الموت الاجتماعي” إلى “ولادة اجتماعية” جديدة، حيث وفرت حياتهم كجنود في الجيش المصري لهم فرصًا للراحة المنزلية والأمن الاقتصادي، بل والترقي، بالإضافة إلى أشكال جديدة من الشرف والسلطة. فلم يتمكنوا من الصعود في الرتب فحسب، بل مُنحوا امتيازاتٍ في بعض الأمور لم تُمنح لقوات أنجلو-مصرية أخرى، مثل رواتب أعلى من المجندين المصريين، وإمكانية تكوين حياة أسرية أثناء الخدمة.
على أرض المعركة، تصرف الجنود السودانيون باستقلالية غالبًا، مفضِّلين تكتيكاتهم القتالية الخاصة على تلك التي يفرضها ضباطهم، مما أثار سخط الأخيرين أحيانًا، لكنه أظهر أيضًا اقتناعهم الراسخ – وحقيقتهم في بعض الحالات – بأنهم أدرى من البريطانيين بكيفية هزيمة المهديين. وهكذا، كانوا في الوقت نفسه أدوات استعمارية وصنّاع مصيرهم، يُعيدون تشكيل تاريخ السودان كما أعاد تاريخ السودان تشكيل حياتهم.
ولا يجب نسيان أن مجرد وجود الجنود السودانيين – وقدرتهم المحتملة، التي رأى بعض دعاة الاستعمار أنها جزء من معادلة صفرية بين إنجلترا ومنافسيها – أثَّر في “العقلية الرسمية” للفيكتوريين، وبالتالي في المسألة المصرية وفي النهاية التدافع على أفريقيا، المرتبطة بحلم الإمبرياليين البريطانيين بمد نفوذهم “من الرأس إلى القاهرة”.
بالطبع، كانت فئة “الجندي السوداني” – كتصنيف عسكري – بناءً ناشئًا عن الإمبراطورية والعنصرية، ومُفروضًا من الخارج. ومع ذلك، أصبح هذا التصنيف العسكري نبوءة تحقق ذاتها. فبفخرهم ومهاراتهم وخبرتهم وموثوقيتهم، وارتباطهم بالحظ والأخوة، وإسلامهم، وولائهم للخديوي والقائد، كان الجنود السودانيون أنفسهم من جعلوا هذا التصنيف ثابتًا. بل إنهم – علاوة على ذلك – من أضفوا عليه طبقات من العمق والمعنى الاجتماعي، وتركوا كإرث لهم هوية وثقافة “سودانية” (يُشار إليها أحيانًا بـ”نوبية”)، انتشرت وتشكلت واستمرت في التعبير عن نفسها خلال القرن العشرين وما بعده، سواء في السودان أو عبر شرق أفريقيا – من بنادق الملك الأفريقية إلى قوة دفاع السودان، ومن عصبة العلم الأبيض إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان.
المصادر:
(Slaves of Fortune – Sudanese Soldiers& the River War (1896–1898
RONALD M. LAMOTHE

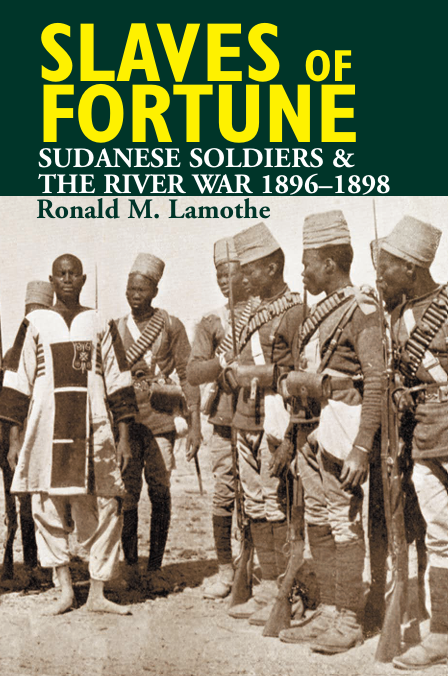
اترك تعليقاً