مقدمة:
يسمي السوداني نفسه زول، لأنه موقن بالزوال والفناء، عمامته كفن، إذا ضحك إستغفر، وإذا بكى حمد الله، يبحث السوداني عن خلود مستتر، خلود سرابي في غناء حكامة، في جلالة لا معنى لها، سوى فتح هوة العدم. يُفني السودانيين أنفسهم بضراوة، و كأنهم يحملون جينات هلاكهم، عصابيين، سايكوباثيين، ممالكهم كلها في الموت، فتسير فيهم نبؤات الهلاك، يتلقفونها من قصص الجدات، تراهم يرقبون الخرطوم لكي تصل سوبا، ليدمروها كما قالت عجوبة.
يموت العشرات لأجل ماعز دخلت حقلاً، يموت المئات لأجل ماعز في القيادة العامة، يقضي حُكام الخرطوم حيواتهم كثقوب سوداء، تتمدد أعمارهم عبر إبتلاع أرواح شعوبهم، فلم يأت حاكم إلا وقد أوغل في دم السودانيين، وكأنه طقس وثني قديم، وكأن القتل والتعذيب لم يكونا بالنسبة لهم سوى وسائل لقضاء الوقت!
حارب السودانيون أنفسهم خمسين عام، فأفنى بعضه البعض، حتى الخرطوم ذاتها شيدت على رفاة، وفي جبل صحابة شمال الخرطوم أقدم مظهر إقتتال لمجموعة هوموسبيان، إعتاد السودانيين على دفن موتاهم في بيوتهم، فلم تعد هناك مسافة بين مساحة الحياة والموت، عند الأعياد يزورون الموتى، و عند الأحقاد يدفنون أحقادهم في المدافن، وعند الأفراح يذكرون الموتى، و عند الإستغاثة لأجل الحياة يزورون المقابر، في الأعراس يبشرون بعتاد الموت، وعند الأتراح يضجون بالحياة، وكأنه لا موت بعد الموت الذي يموتونه.
حارب السودانيون الرصاص لأول مرة في كورتي، عند مجئ الترك، لأنهم لم يعرفوه، ويحارب السودانيين الرصاص الأن و كأنهم يعرفوه. حارب الأولاد، مسيلات الغاز، بنادق الخرطوش، الكلاشينكوف، رصاص السُكسك، أرتال شرطة الشغب، تاتشرات الأمن، كل ذلك تم لأجل الحياة ولم يعرفوها.
حارب السودانيون الرصاص في المكسيك، في السويس، حاربوا بعضهم في سفوح الرمال الدموية، خلقوا أسطورتهم من التراب، وإلى التراب يعودوا.
عندما يقترب الموت من السوداني، يعرفه وربما يسلم عليه، ويقول له حبابك.!

سيجئ الموت وستعرفه، وسيكون له عيناك.!
ويطلق على الموت تسميات عديدة باللهجات واللغات السودانية: ويمكن القول إن معظمها وظيفي : ناتج وظائف مهنية – ومنها رثائي – وأخر إستخفافي – ومنها اللطيف في الوصف -أو المتعلق بتفاصيل القبر- ومنها ما يميل للبلاغة والإستعارة..
الموتُ في اللغة العربية
يسمى الموت ب: الشَعُوب – وهو إسم مؤنّث، من التشعب أي التفرقة، حيث يفترق الإنسان بموته عمّن حوله، ويُطلق عليه أمّ اللهيم – لربما من الغريب جداً أن يسمى الموت بالأمّ، ولكنّ الأمّ التي نتحدث عنها هنا أمّ مخيفة، إذ يشار باللهيم إلى الالتهام، كناية عن أنّ الموت يلتهم الشخص حين وفاته. ويسمى الموت بالنيّط – وهو العِرق الذي عُلّق به القلب، فإذا قٌطِع هذا العرق مات صاحبه، الأمر الذي جعل هذا الاسم من أسماء الموت أيضاً، إذ يقال: “رماه الله بالنيط، أي بالموت”.
الرمْد – جاء الرمْد كأحد أسماء الموت في كتاب “المخصص” ، وقد عرف الإسلام فترة من الزمن عُرفت بعام الرّمادة أي عام الموت.
ويسمى المنون لأنه يذهب بمنّة الإنسان، أي قوّته، ويقال جبل منين، أي ضعيف. وكذلك الموتُ.
ونجد في تشبيهات الموت : التشبيهات الوظيفية الخارجة من مهنة ما : سواء كان أفندية يعملون في المكاتب / أو أطباء في المستشفيات / أو ميكانيكية من المنطقة الصناعية :وهي كالأتي : باصا : من الحقل الطبي ، ومنها ما هو آت من ورش الميكانيكا: مثل قولهم : فلان قطع كرنكي/ فلان قطع شفاط.!
سلم ورقو: مصطلح مكتبي بحت
ونجد عبارة أن أجله تم وهي تعنى تمام الأجل وفيها ما هو محدث مثل: يومو إنتهى / انترم/ انجغم/ ودع/ سلم ورقو/ تكل / باص
أما صغير حام وتعني أن هناك موت بالجمله
زايلي وتعني الزوال والفناء
علَّق نعلاتو وهي تشابه ما ورد في نص شعري عن عاطف خيري : الموت ان يستلقي الرجل بعيدآ وحذائه بالبيت. (وهي أنه ما عاد في حاجة للمشي! – ما عادت لها وجهة يقصدها!)..
ومن الكلمات البليغة : يقال إن فلان لحق الزينين : أي مات وإلتحق بالناس الزينيين وهي جمع لكلمة زين وهو الشخص السعيد.
الموت سمبلا – وهي عن الموت جماعة.
ويقال فلان رقد أي مات / وإنتكأ : إتكأ / ويقال أن فلاناً قد مشى وتعني أنه مات
(إذ تصير حركات السوداني في مجملها تعبيراً عن الموت)
إتوسد يمينو : في إشارة إلى الرقود في اللحد
خت راسو صعيد: بمعنى توسد القبر تجاه القبلة
كوع على جرحوا اليسار وهي أوصاف للرقود في القبر.
إتوسد الباردة : والتوسد هنا الرقود المريح.
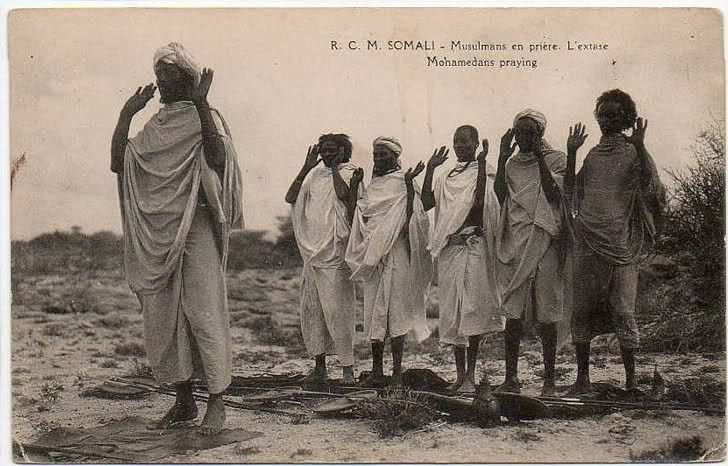
وفي وصف القبر نجد تسمية السودانيين له بالهوة وهي الحفرة في الأرض . قال بعضهم يمتدح الشيخ حسن حسونة
ناديته ساكن الهوه ،
كاسر الأسود القوة
كاسر الأسود هازمها
وهي عربية أيضاً . ومن أمثال العرب (وقعوا في هوة تترامى بهم أرجاؤها ) – الأرجاء الجوانب ـ وقال حسان بن ثابت (كما ساور الهوة الثعلب )
ويقال إن فلان شٍبِعْ تراب : إذا مات.أو اتوسد تقيلة
كمل المعدودة: إنتهت أيامه في الحياة – سلمّ الأمانة : أسلم الروح.
ويقال إن “فلان سَكْت” صمت، الصمت مفهوم عند مجتمعاتنا بالموت، لأنه علاقتك مع محيطك مرتبط بالكلام (الحكي هو الحياة).
ابا الكسرى: أي رفض الأكل. كما نجد كلمة مثل (إندرش الشخص) أي هلك كالعيش و (درش ) الذرة ونحوها جرشها أبدلوا الجيم دالا ففي القاموس عطفاً على معانيها والشيء لم ينعم دقه فهو جريش » أو إن فلان أبى الماريق : والماريق هي الذرة الصفراء.
ويقال إن فلان إنجغم أي هلك، وهي من (جغم) الماء في لغتنا جرعه والجغمة بالضم الجرعة وأصله غمج – ففي القاموس غمج الماء كضرب وفرح جرعه والغمجة بالضم الجرعة وككتف الفصيل يتغامج بين ارفاق أمه اهـ »
إتودر وهي من (الودر) وهو الفناء : وقد جاء في النص الشعري:
أماتو قالنو اللدر …. مالنا بنشوف جسمك خدر
قال ليهن الدم بنحدر …. وان مت ما تقولن وِدر
كَبرا – تَكّل – ودّع – فالأولى تعني إنه هرب / وتكّل : بمعنى مشى / و ودع أي أنه فارق أحبائه بالوداع.
عضا سنينات : وهي كناية عن فعل إنتزاع الروح والضغط على الأسنان
نكفي قدحو / فالشخص إذا إنكفأ قدحه مات و القدح هو صحن الأكل فلما يموت الشخص يكفأ الصحن الذي كان يأكل فيه
ويوم الموت يسمى بيوم الشكر، ويقال في الدعاء بالحياة للشخص: ربنا ما جاب يوم شكرك..
ومن الكلمات التي أصلها قديم : اترحَّل للتشبيه عن الرحلة.!
اتقدَّم الجنة ، ودع الفانية – اختار ربو ، الله اختارو وهي دعاء للرحمة مثل : في ودائع الرحمن ، سلم امانتو ، رفع قلمو.
بينما نجد تشبيهات مثل : تلب صقرو – غرب نجمو
أما ما بقي من التركية القديمة : يقال إن فلان قدا : أي مات.
ديوسو وهي تعني الموت باللغة النوبية / او في منطقة دنقلة يعرف : دياسكوو. ويقال فلان “دِيو…أو دِيوسو” “والديس تعني الدم” اللغة النوبية المحس والسِكوت بشمال السودان.
أما في لغة الفلفدي “البولاكو” الناطقين بيها الفولان أو الفلاتة فالموت يعني : ” فلان مايّ” أي فلان مات – يقال: ” مايّدي” أي الموت .. يقال:” ورو مايّدي” أي بيت البكاء..
الموت في البداوييت ينطق هكذا : تويّت ولانو حرف ت و الواو يستخدم للمعرفة في حالة المؤنث و الموت كلمة مؤنثة في البداوييت و لو مذكر ستكون الكلمة اويّت لانو المعرفة المذكر في البداوييت يعرف بحرف الالف و الواو. كلمة موت نكرة ستكون :يّت مع تشديد الياء. ومنها يقولوا “منا دنياتميا” الجملة مشابهة لي دنيا زايلة.
أما عند البني عامر (الناطقين بالتقراييت) فيقال : فلان ترحّما ” اي فلان توفى أو مات / ويقال ايضاً ” اتشفّعا ” في موت الأطفال حديثي الولادة..
قصة أمات طه – الفناء الجماعي
(لحق أمات طه) : وجاء في حكايتهن أنه عاش في الزمن الماضي، سبع شقيقات ولم يكن لهن شقيق، فنشأن مترابطات متحابات كأنهن جسد واحد، والغريبة أن سهم (البورة) النافذ قد أصاب أؤلئك الشقيقات جميعا، أي أنهن لم يتزوجن ما عدا واحدة فيهن جاءها (السعد) ناقصا، لأنها بعد أن تزوجت لم تتهنى بزواجها طويلا، فقد توفى عنها زوجها بعد انجابها لابنها البكر أو (الأول والأخير) والذي أسمته (طه) بعد وفاة الزوج حملت أم (طه) صغيرها، وعادت لتعيش مع أخواتها، وهكذا نشأ (طه) في غرفة (العناية المكثفة) التي بنتها حوله أمه وخالاته الستة، ولشدة تعلقهن به جميعا اعتبرت كل واحدة منهن أن طه (ود مصرانها) شخصيا، حتى أن الناس أطلقوا على الأخوات كنية (أمات طه)، لتفانيهن في خدمته وتلبة طلباته ولو كانت باستحالة (لبن الطير)، ولكن لأن (ما زاد عن حده انقلب إلى ضده) فقد ضاق (طه) زرعا بوصاية أمه وخالاته عليه، ولازمه الشعور بـ (الخنقة) من كثرة الحنان والمحبة المدلوقين عليه بدون حساب، فكان ينهيهن عن متابعته وملاحقتهن له ولكن دون جدوى، حتى أصابته (عقدة) من معايرة الناس له بدلع أماته، فحمل مخلايته سرا في ذات زهجة و(فزّ) من الحلّة بالفيها هربا من (حنانن) ..
أصاب الفزع (أمات طه) عندما علمن بخبر هروبه منهن، وأسرعن بالخروج للخلاء خلفه علّهن يتمكن من اللحاق به واقناعه بالعودة معهن، ولاستعجالهن للخروج لم يهتمن باصطحاب (دليل) أو أخذ (الزوادة) لتعينهن على السفر، ثم (تمت الناقصة) عندما ضلّن الطريق وتاهن في الخلاء لأيام حتى هلكن جميعا بسبب الجوع والعطش، فصرن مضرب مثل لفاجعة الموت الجماعي !

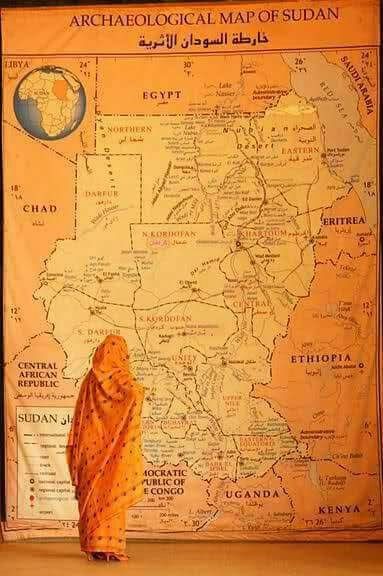
اترك تعليقاً